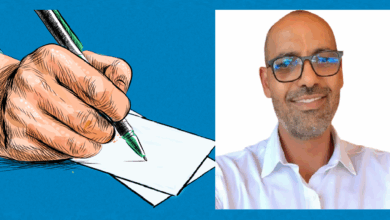نزار الجليدي يكتب لكم/ منتدى دافوس وتونس في مواجهة الواقع الدولي

في المنتدى الاقتصادي العالمي، عرضت تونس خياراتها الاقتصادية أمام ممثلي أكثر من 130 دولة. من الناحية الدبلوماسية، يظل هذا الحضور مفيدًا. غير أنّ عالمًا يتجه نحو الانغلاق وإعادة التموضع لم يعد يكتفي بدبلوماسية المنتديات. انسحاب أمريكي متزايد من المنظمات العالمية، وأوروبا ضعيفة استراتيجيًا لكنها ما تزال تفرض معاييرها، واختلالات تجارية مستمرة: لم يعد الرهان اليوم هو الظهور، بل امتلاك قراءة واضحة للشركاء، وللمصالح، وللخطوط الحمراء.
كل عام يعود منتدى دافوس كطقس متكرر. يلتقي القادة، تتقاطع الخطابات، وتُتداول الوعود. بالنسبة إلى تونس، المشاركة ليست شكلية ولا زائدة عن الحاجة. فهي تتيح لها البقاء حاضرة في فضاء ما تزال تُصاغ فيه سرديات الاقتصاد العالمي، وتُنسج فيه علاقات قد تكون مفيدة. لكن دافوس ليس ساحة قرارات ملزمة. إنه واجهة عرض، لا أداة اختراق.
أصبحت هذه التفرقة اليوم حاسمة. ففي أفق 2026، لا تواجه تونس مجرد حاجة إضافية إلى الاستثمار، بل تعيش تحت ضغط ماكرو-اقتصادي دقيق، مُقاس بالأرقام وممتد في الزمن. خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2025، تجاوز العجز التجاري 20 مليار دينار، فيما تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 74.2%. هذا الخلل ليس ظرفيًا ولا عابرًا، بل بنيوي، تغذّيه فاتورة الطاقة، والمدخلات الإنتاجية، ومعدات التجهيز. ولا يمكن لأي خطاب، مهما كانت بلاغته، أن يتجاوز هذه الحقيقة.
في الوقت نفسه، تغيّر السياق الدولي من حيث طبيعته. الولايات المتحدة تنسحب من عشرات المنظمات الدولية التي تعتبرها متعارضة مع مصالحها. أوروبا تعجز عن تحويل ثقلها الاقتصادي إلى قدرة استراتيجية حقيقية. أما المنظمات الدولية، فبقيت قائمة، لكن بهوامش تأثير متقلصة. الاستمرار في التفكير وكأن العالم ما يزال يعمل وفق توازنات الأمس يفتح الباب أمام أخطاء جسيمة في التقدير.
ضمن هذا السياق تحديدًا يجب فهم المشاركة التونسية في دافوس. لا بوصفها غاية في حد ذاتها، بل أداة من بين أدوات أخرى. فالسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت تونس حاضرة، بل ما الذي تسعى فعليًا إلى تصحيحه، ومع من، وتحت أي شروط.
دافوس: واجهة مفيدة، ولكن…
تندرج مشاركة الوفد التونسي في دافوس 2026 ضمن مسار بات مألوفًا ومُحكمًا. فقد مثّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ البلاد في منتدى يضم أكثر من 130 دولة، بهدف واضح: تكثيف اللقاءات، عرض الأولويات الوطنية، والحفاظ على حضور تونس ضمن دائرة اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية. من الزاوية الدبلوماسية، يبدو هذا التوجّه منسجمًا ومنطقيًا.
يوفّر دافوس ما لم تعد توفره إلا مساحات قليلة على المستوى الدولي: تركيزًا استثنائيًا للفاعلين الماليين، ومؤسسات التنمية، وصنّاع القرار العموميين. فاللقاءات الثنائية التي تُنظَّم على هامش المنتدى — مع بنوك تنمية، وهيئات أممية، أو شركاء إقليميين — قد تفضي إلى تعاون تقني، أو مشاريع محددة، أو دعم مؤسسي. ومن هذا المنظور، كان الغياب سيُعدّ خطأً.
غير أن لدافوس حدوده، وهي حدود بنيوية. فهو ليس فضاءً للتفاوض التجاري، ولا ساحة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية. الخطابات التي تُطلق فيه لا تعوّض سياسة طاقية، ولا استراتيجية صناعية، ولا عقيدة تجارية واضحة. وهي، بمفردها، لا تغيّر ميزانًا تجاريًا يعاني عجزًا يتجاوز 20 مليار دينار.
الخطر بالنسبة إلى بلد واقع تحت الضغط هو الخلط بين الظهور والتحوّل. أن يُسمَع الصوت لا يعني أن يُدعَم، وأن تُوجَّه الدعوة لا يعني أن تُمنَح الأولوية. يثمّن دافوس القدرة على سرد مسار أو رواية اقتصادية، لكنه لا يضمن التمويل، ولا يضمن تطابق المصالح. وفي عالم تتزايد فيه انتقائية رؤوس الأموال، وتغدو فيه الدول أكثر واقعية، تصبح هذه الفوارق حاسمة.
لهذا، لا يمكن تقييم المشاركة التونسية إلا من خلال سؤال واحد بسيط: هل تخدم ترتيبًا واضحًا للأولويات الاقتصادية الملحّة، أم تكتفي بالحفاظ على حضور رمزي؟ الجواب لا يتوقف على طبيعة الخطابات، بقدر ما يرتبط بقدرة تونس على قراءة العالم كما أصبح، لا كما كان.
الواقع الاقتصادي: ما الذي ينبغي على تونس تصحيحه على وجه الأولوية
إذا كان دافوس يوفّر منصة للعرض، فإن تونس تحمل في المقابل حصيلة واضحة المعالم، دقيقة الأرقام، وصعبة الاخفاء. خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2025، تجاوز العجز التجاري 20.1 مليار دينار، فيما تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 74.2% مقابل أكثر من 77% قبل عام. هذا التراجع ليس هامشيًا، بل يعكس تآكلًا تدريجيًا في قدرة البلاد على تمويل حاجاتها الخارجية من إنتاجها الخاص، أو على تثمين هذا الإنتاج.
لكن تركيب هذا العجز أكثر دلالة من حجمه. إذ تستأثر الطاقة وحدها بأكثر من نصف الاختلال، بعجز يفوق 11 مليار دينار. تليها المواد الأولية ونصف المصنعة، ثم معدات التجهيز. بعبارة أخرى، تستورد تونس بكلفة مرتفعة ما يمكّنها من الإنتاج، والحركة، والتشغيل. ليست المشكلة استهلاكًا مفرطًا، بل تبعية بنيوية.
في المقابل، يظل القطاع الغذائي محققًا لفائض. هذا الفائض، الذي يُستحضَر كثيرًا في النقاش العام، يلعب دورًا تعويضيًا جزئيًا، لكنه غير كافٍ لتعويض ثقل الطاقة والمدخلات الصناعية. وهو يكشف، في العمق، هشاشة بنيوية: اقتصاد يواصل تصدير منتجات منخفضة القيمة المضافة، ويستورد في الوقت نفسه ما يحدد قدرته على الارتقاء في السلسلة الإنتاجية.
هنا يجب أن تتوقف الدبلوماسية الاقتصادية عن كونها خطابًا عامًا. فالحديث عن الجاذبية، والابتكار، أو التمويل المستدام لا معنى له ما لم يترجم إلى تقليص ملموس لأسباب العجز. جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته؛ بل السؤال الحقيقي هو ما إذا كان هذا الاستثمار يخفّض فاتورة الطاقة، أو يعوّض الواردات، أو يعزّز القدرة الإنتاجية المحلية.
في هذا السياق، يصبح الخطاب العام في المنتديات الدولية مسألة ثانوية. ما يهم هو مدى التناسق بين الشركاء الذين تُوجَّه إليهم الجهود، والاختلالات التي يتعيّن تصحيحها. الاقتصاد التونسي لا يملك ترف تشتيت المسارات دون ترتيب واضح للأولويات. عليه أن يفكّر بمنطق البنود التي يجب معالجتها، والتبعيات التي ينبغي تقليصها، وهوامش الحركة التي يتعين استعادتها.
دافوس لا يقدّم إجابات عن هذه الأسئلة، لكنه يجعلها أكثر وضوحًا. وتبقى المسؤولية بعد ذلك على عاتق الدولة لتحويل هذا الظهور إلى قرارات واضحة: أي القطاعات ينبغي حمايتها، أي الشراكات يجب تفضيلها، وقبل كل شيء، أي الأوهام يجب التخلي عنها.
الأونكتاد: أداة تقنية لا طوق نجاة
قُدِّم الإعلان عن لقاء مرتقب مع الأمينة العامة للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، ريبيكا غرينسبان، واحتمال قيامها بزيارة إلى تونس، على أنه إشارة إيجابية. وهو كذلك على المستوى المؤسساتي. غير أنّ الدقة تقتضي تسمية الأمور بمسمياتها، دون إسقاط قدرات على المنظمة لا تمتلكها.
فالأونكتاد ليست بنك تنمية، ولا جهة تمويل كبرى. إنها هيئة خبرة تقنية بالأساس. تضم نحو أربعمائة موظف، وتعمل بميزانية سنوية محدودة قياسًا بحاجات الدول: ميزانية عادية في حدود سبعين مليون دولار، تُستكمل بأموال خارج الميزانية مخصصة للمساعدة التقنية. دورها واضح: دعم البلدان النامية في سياسات المنافسة، والاستثمار، والتجارة، والتنظيم. هي تدرّب، وتستشير، وترافق. لكنها لا تعيد تمويل اقتصاد واقع تحت الضغط.
هذه التفرقة أساسية. ففي النقاش العام التونسي، كثيرًا ما تُفهم إعلانات التعاون الدولي باعتبارها حلولًا مالية ضمنية. والحال أنّ الأونكتاد، حتى في أفضل السيناريوهات، لا تتدخل إلا في المراحل التمهيدية: تحسين الأطر القانونية، تعزيز القدرات الإدارية، وتوضيح الاستراتيجيات. وهي لا تعوّض عجزًا طاقيًا يتجاوز 11 مليار دينار، ولا اختلالًا تجاريًا بنيويًا.
ويجعل السياق الدولي هذه الواقعية أكثر إلحاحًا. فالولايات المتحدة شرعت رسميًا في الانسحاب من عشرات المنظمات الدولية التي تعتبرها متعارضة مع مصالحها الاستراتيجية. هذا التوجه لا يستهدف مؤسسة بعينها، لكنه يعيد تشكيل المنظومة متعددة الأطراف: موارد أقل، شروط أكثر، وتسييس متزايد للمساعدة التقنية. في هذا الإطار، لا يمكن اعتبار أي منظمة أممية شبكة أمان دائمة.والأونكتاد تحديدًا لن يكون بمقدورها دعم تعاونها مع تونس بأموال أمريكية. وعليه، فإن تقديم تنازلات في السياسة الاقتصادية على أساس اتفاق مستقبلي مع هذه المنظمة لن يفضي إلى أي أثر ملموس.
من ثمّ، ينبغي قراءة الزيارة المرتقبة للأمينة العامة للأونكتاد في إطارها الحقيقي: فرصة لعمل تقني موجّه، لا وعدًا بدعماقتصادي. يمكنها أن تساهم في تحسين هيكلة بعض السياسات العمومية، لكنها لن تكون يومًا بديلًا عن قرارات سيادية في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، أو في اختيار الشركاء التجاريين.
أما الخطر الحقيقي، فيكمن في الاعتقاد بأن الأجندة الاقتصادية الدولية، كما كانت تعمل قبل عشرة أو خمسة عشر عامًا، ما تزال صالحة اليوم. عالم 2026 لم يعد ذلك العالم الذي كانت فيه المنظمات الدولية تمتص الصدمات. إنه عالم تواكب فيه هذه المؤسسات، على الهامش، استراتيجيات صاغتها الدول مسبقًا. وبدون استراتيجية واضحة، يصبح دورها شكليًا لا أكثر.
أوروبا، الزراعة، والاحتكار: تونس في مواجهة مناطقها العمياء
هنا يتحوّل النقاش إلى نقاش سياسي، ويجب أن يكون كذلك. فخلف الخطابات الناعمة في دافوس ووعود التعاون التقني، تختبئ مسألة مركزية يتجنبها كثير من المحللين: من المستفيد الحقيقي من الأجندة الاقتصادية المطروحة على تونس، وعلى أي قطاعات يُمارَس الضغط الخارجي الأساسي؟
تقف الزراعة في صلب هذا التوتر. فهي ما تزال أحد أهم بنود الصادرات التونسية نحو أوروبا، بل ونحو الغرب عمومًا. غير أن هذا الأداء الظاهر يخفي هشاشة عميقة. فالخيارات الإنتاجية تُملَى بشكل متزايد من الطلب الخارجي، على حساب التكيف مع الواقع البيئي التونسي. بذور مستوردة، أصناف ضعيفة التلاؤم مع الشحّ المائي، ومنطق مردودية قصيرة الأمد: كل ذلك يساهم في إضعاف منظومة تعاني أصلًا من الجفاف وندرة المياه.
هذا النموذج ليس محايدًا. بل هو مدفوع، ومشجَّع، وأحيانًا مفروض عبر شبكات تعاون زراعي وتجاري مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسوق الأوروبية. فالتعاونيات الزراعية ومراكز التخزين والتبريد، التي تُقدَّم غالبًا بوصفها فاعلًا تقنيًا، تؤدي في الواقع دورًا سياسيًا: فهي توجّه اختيارات البذور، وتُعيد تشكيل سلاسل الإنتاج، وتُحكم السيطرة على المنافذ. وطالما استجابت الكميات المصدَّرة للمعايير الأوروبية، تتراجع مسألة الاستدامة المحلية إلى مرتبة ثانوية.
هنا تحديدًا تصبح أوهام التعاون الدولي خطِرة. فالمنظمات الدولية، بما فيها تلك ذات الطابع التقني، تعمل اليوم ضمن بيئة باتت أكثر انسجامًا مع أولويات القوى الاقتصادية الكبرى. والحياد لا يصمد طويلًا أمام موازين القوة التجارية. وعندما تُستبعَد تونس من بعض منتديات الاستثمار في محيطها الإقليمي، أو تُهمَّش ضمن أجندات زراعية عالمية، فذلك ليس مصادفة، بل انعكاس لاختلاف المصالح.
ضمن هذا السياق، لا يمكن التعامل مع الزيارة المرتقبة للأمينة العامة للأونكتاد بمعزل عن محيطها. فهي تأتي في لحظة تسعى فيها أوروبا إلى تأمين سلاسل إمدادها الزراعية، مع نقل جزء من الكلفة البيئية والاجتماعية إلى الخارج. ولا يمكن لتونس أن تكتفي بمرافقة هذا التوجه دون فرض شروطها الخاصة. فالاكتفاء بمنطق التصدير، دون مساءلة مسألة السيادة البذرية والغذائية، هو في الواقع تمهيد لأزمات قادمة.
وربما يكمن الجانب الأكثر إثارة للقلق في مكان آخر. فجزء من الخطاب الاقتصادي التونسي ما يزال يتعامل مع هذه القضايا باعتبارها ملفات تقنية، في حين أنها في جوهرها قضايا استراتيجية. الزراعة ليست قطاعًا كسائر القطاعات. إنها تمس الأمن الغذائي، والتوازنات الجهوية، والقدرة على الصمود في وجه التغير المناخي. وتركها تُدار من الخارج، حتى تحت غطاء التعاون، يظل رهانًا محفوفًا بالمخاطر.
تونس لا تحتاج إلى القطيعة مع أوروبا، لكنها تحتاج إلى خطاب مختلف معها. خطاب يذكّر بأن النفاذ إلى أسواقها الزراعية لا يمكن أن يتم على حساب إنهاكها البيئي. وأن الاستدامة لا تُقرَّر في المنتديات، بل تُبنى في الحقول، عبر خيارات سيادية في البذور، والمياه، وأولويات الإنتاج.
مخاطبة الشركاء الصحيحين: إعادة توجيه الدبلوماسية الاقتصادية نحو الاختلالات الحقيقية
أحد مفارقات النقاش الاقتصادي في تونس يتمثل في أن الجزء الأكبر من الطاقة السياسية والإعلامية يُصرف على الشركاء الغربيين، في حين أن أثقل الاختلالات تتشكل في أماكن أخرى. أوروبا والولايات المتحدة تحتلان الحيز الرمزي، لكنهما لا تفسران وحدهما الهشاشة البنيوية للتجارة الخارجية التونسية.
الأرقام لا تحتمل التأويل. فالعجز التجاري الإجمالي يتجاوز عشرين مليار دينار خلال أحد عشر شهرًا، وهو مدفوع ببنود محددة: الطاقة، والمدخلات الصناعية، ومعدات التجهيز. أي بما لا تنتجه تونس، أو لم تعد تنتجه، وتضطر إلى استيراده لضمان سير اقتصادها. هذه هي البنود التي ينبغي أن تحدد أولويات التحرك الدبلوماسي.
غير أن الشركاء المهيمنين في هذه المجالات ليسوا أوروبيين. فقد أصبحت الصين موردًا محوريًا للمواد الوسيطة ولمعدات الإنتاج، فيما تحتل تركيا موقعًا متناميًا في عدة سلاسل صناعية وتجارية. ومع هذين البلدين يتسع العجز عامًا بعد عام. الاستمرار في التعامل مع الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها واجهة للوجاهة الغربية، دون فتح حوار استراتيجي معمق مع هؤلاء الأطراف، يعني تجاهل الآلية الفعلية للاختلال.
لا يعني ذلك تحولًا أيديولوجيًا، ولا انقلابًا في التحالفات. بل هو تصحيح عقلاني للمسار. فاقتصاد واقع تحت الضغط لا يملك خيار تشتيت الجهود دون ترتيب. عليه أن يركز حيث يكون الأثر التصحيحي أكبر: تعويض الواردات، نقل التكنولوجيا، الإنتاج المشترك، وتأمين البضائع الحيوية.
في هذا الإطار، تتقاطع المسألة الزراعية مع المسألة الصناعية. فإذا واصلت تونس تصدير منتجات فلاحية نحو أوروبا وفق معايير خارجية، وفي الوقت نفسه استيراد البذور، والأسمدة، والطاقة، والمعدات، فإنها تظل حبيسة حلقة تبعية مغلقة. إن مقاربة الزراعة فقط من زاوية الأسواق التي تستوعب الفائض هي خطأ منهجي. النقاشات الاستراتيجية يجب أن تستهدف من يحدد بنية الكلفة، لا فقط من يستهلك الكميات.
وتفرض هذه المراجعة كذلك تغييرًا في الخطاب. أقل من الشعارات حول الجاذبية، وأكثر من الوضوح في الأهداف. أقل من التواصل، وأكثر من التفاوض. فالدول باتت تفكر بمنطق سلاسل القيمة والأمن الاقتصادي، ولا يمكن لتونس أن تواصل الفصل بين الدبلوماسية، والتجارة، والسيادة الإنتاجية.
في هذا المنظور، لا يعدّ دافوس سوى محطة عابرة. ما يهم هو ما يأتي بعدها: مع من يتم التفاوض، حول ماذا، وتحت أي شروط. أما ما عدا ذلك، فليس سوى جزء من المشهد.
الخروج من المنتديات، الدخول في التاريخ
ليست مشكلة تونس في ضعف الحضور أو قلة الظهور، بل في طريقة قراءة العالم. فدافوس ليس خطأ، ولا زلّة. إنه أداة لا أكثر. غير أنّ الأداة لا تصنع استراتيجية، ولا يمكن أن تكون بوصلة. وعندما يختلط الظهور بالقوة، والحوار بالتأثير، والتعاون بالحماية، ينشأ وهم مفاده أن الخطاب قادر وحده على تعويض الاختلالات.
عالم 2026 لم يعد يعمل بهذه الطريقة. الدول تنسحب من المنظمات عندما تكفّ عن خدمة مصالحها. الشركاء التاريخيون يتحولون إلى ضيف ثقيل دون أن يكونوا متضامنين. القوانين تتراجع أمام موازين القوة. ومن يواصل التفكير وكأن النظام الدولي ما زال يحمي الأضعف، يجد نفسه متأخرًا عن حركة التاريخ.
تونس ليست معزولة، لكنها مكشوفة. مكشوفة بتبعيتها الطاقية. مكشوفة بخيارات زراعية موجهة نحو التصدير دون حماية بعيدة المدى. مكشوفة بدبلوماسية اقتصادية تخاطب كثيرًا شركاء لا يمثلون أصل المشكلة البنيوية، وتتجاهل نسبيًا من يساهمون فعليًا في تعميق العجز. ومكشوفة، أخيرًا، بوهم أن الزيارات المؤسساتية يمكن أن تعوّض غياب خطوط حمراء واضحة.
لا يتعلق الأمر بالقطيعة، ولا بالاصطفاف الأعمى في اتجاه آخر. بل بإعادة بناء خطاب مفهوم، وموقف حازم، ومسار منسجم. بأن تُطرح الزراعة باعتبارها مسألة سيادة، لا مجرد مسألة مردودية. وأن يُنظر إلى التجارة كأداة لتصحيح الاختلالات، لا كتمرين تواصلي. وأن تُعامَل المنظمات الدولية كما أصبحت عليه فعلًا: فضاءات تقنية، مفيدة ولكن محدودة، لا دروعًا واقية ولا سلطات مرجعية.
التاريخ ليس قاسيًا، لكنه غير مبالٍ. يمضي مع من يتكيّف معه، ويترك خلفه من يخلط بين الديكور والمشهد. لا تزال لدى تونس هوامش، ولا تزال لديها خيارات. لكنها لم تعد تملك خيار الغموض. الخروج من المنتديات لا يعني الصمت، بل اتخاذ القرار. واتخاذ القرار اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة.