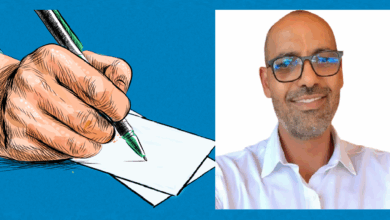نزار الجليدي يكتب لكم/ السيولة، العقارات، ووهم الاستقرار النقدي: تونس في مواجهة قنبلة مالية


في تونس اليوم، الأوراق النقدية رثّة، التعامل بالسيولة طغى على المسالك الاقتصادية، والعقار أصبح خارج متناول الأغلبية: مؤشرات واضحة، تكاد تتحول إلى مشهد نمطي. لكن خلف هذا التطبيع، تتشكل آلية خطيرة، تغذيها الاقتصاديات الموازية، تآكل الثقة في المنظومة البنكية، وخيارات البنك المركزي. تونس تتقدم نحو انفجار فقاعة مالية وعقارية لن تكون قادرة على تحمّل كلفتها. ورغم ذلك، لم يفت الأوان بعد لتفادي الأسوأ.
يكفي سحب مبلغ من أي موزّع آلي، في أي مكان في تونس، لفهم أن شيئًا ما لم يعد يسير كما يجب. أوراق نقدية بالية، قديمة، أحيانًا ملصوقة بشريط لاصق، تتداول بكثافة في اقتصاد عاد فيه النقد (“الكاش”) ليصبح القاعدة. هذا ليس تفصيلاً عابرًا. إنه دليل على وضعية خطرة.
في جانفي 2026، بلغت كتلة الأوراق النقدية والعملات المتداولة مستوى تاريخيًا، متجاوزة 27 مليار دينار. في ظرف سنة واحدة، ارتفع هذا الحجم بحوالي 4,5 مليارات دينار. وعند مقارنته بحجم الاقتصاد، تمثل السيولة(العملة الورقية) اليوم أكثر من 15 % من الناتج الداخلي الخام. رقم واحد يكفي لطرح السؤال الجوهري: لماذا يعمل اقتصاد يُفترض أنه مُبنكن بشكل متزايد كاقتصاد نقدي بحت؟
التفسيرات المباشرة معروفة. القوانين الجديدة المنظمة لاستخدام الشيك أدت إلى ارتفاع حاد في التعامل نقدًا. الثقة في البنوك التجارية تآكلت. الخوف من المستقبل يدفع العائلات إلى الاكتناز. لكن هذه الأسباب، مهما كانت واقعية، لا تكفي وحدها لتفسير حجم الظاهرة.
لأن خلف السيولة الظاهرة، تكمن تحوّلات أعمق: اقتصاد ينزاح خارج القنوات الرسمية، بنك مركزي يترك الكتلة النقدية تنفلت — أو يساهم في تغذيتها — ودولة تراقب، بعجز، تشكّل قنبلة مالية موقوتة أمام أعينها. وعلى عكس الأزمات السابقة (2008-2012)، لم تعد تونس اليوم تملك احتياطات من العملة الصعبة قادرة على امتصاص صدمة عنيفة. ما يحدث ليس مجرد اختلال نقدي، بل خطرًا نظاميًا حقيقيًا.
اقتصاد غارق في السيولة: ما يراه الجميع
عودة السيولة إلى صدارة المشهد في تونس ليست ظاهرة خفية. هي ملموسة، يومية، تكاد تكون صادمة. في المحلات، في الأسواق، في المعاملات، النقد هو السيد. لكن الأوراق التي تُوزَّع حديثًا تحمل آثار تداول مفرط، علامة على استعمال كثيف وطويل.
الأرقام تؤكد ما تلتقطه العين. في جانفي 2026، تجاوز رصيد الأوراق النقدية والعملات المتداولة عتبة 27 مليار دينار، مقابل ما يزيد قليلًا عن 22,5 مليارًا قبل سنة. زيادة بنحو 20 % في اثني عشر شهرًا. على المستوى الماكرو-اقتصادي، هذا التطور أبعد ما يكون عن التفصيل. إنه يعكس ابتعادا جزئيًا للتمويل البنكي عن الاقتصاد، وعجزًا متزايدًا للقنوات الرسمية عن امتصاص التدفقات النقدية وتوجيهها.
إصلاح قانون الشيكات لعب دور المُسرِّع. بتقييد استعمال الصكوك وتشديد الرقابة عليها، حوّل كتلًا كاملة من المعاملات نحو النقد. لكن أي إصلاح، مهما كان هيكليًا، لا يخلق النقود. هو فقط يغيّر مساراتها. وهنا، تكاثرت المسارات خارج نظر الدولة التونسية.
هذا التحوّل يخدم أولًا من يعملون أصلًا على الهامش: المهرّبون، التجار غير النظاميين، الوسطاء بلا تتبّع، ومختلف أشكال الجريمة. في اقتصاد تصبح فيه السيولة قاعدة، لا يعود النقد عائقًا بل ميزة تنافسية. يتيح التهرّب من الضرائب، ومن الرقابة، ومن القواعد. وكلما ازداد تداوله، ازداد إضعاف من لا يزالون يحترمون القنوات القانونية.
الأكثر إثارة للقلق ليس وجود الظاهرة، بل التماهي معها. كأن الاقتصاد التونسي اعتاد العمل بحجم سيولة لا يتناسب مع حجمه، ولا مع إنتاجه الحقيقي، ولا مع قدرته على التنظيم. عند هذه النقطة تحديدًا، يتوقف النقاش عن كونه تقنيًا. ويصبح سياسيًا.
الاقتصاد غير المنظم والتهريب: حين يصبح النقد أداة استراتيجية
إذا كان النقد يغزو الاقتصاد التونسي، فليس فقط لأن المواطنين فقدوا الثقة في البنوك. السبب الأعمق هو أن جزءًا كاملًا من النشاط الاقتصادي بات يعمل خارج القواعد، ويجد في ذلك مصلحة مباشرة. السيولة لم تعد مجرد وسيلة دفع. لقد تحولت إلى البنية التحتية للاقتصاد الموازي.
التقديرات المتداولة منذ سنوات تكاد تتطابق: الاقتصاد غير المنظم يمثل أكثر من ثلث الناتج الداخلي الخام. رقم مقلق بحد ذاته، لكنه يكتسب بعدًا أخطر حين يُقارن بالانفجار الحاصل في العملة الورقية. اقتصاد يعمل على نطاق واسع خارج الدوائر البنكية يحتاج إلى نقد. إلى الكثير من النقد. وهذا النقد يدور بسرعة، ولفترات طويلة، دون أي تتبع. أما مصادر هذه السيولة، فلا يمكن إلا أن تكون إجرامية، لأن حاجيات السوق هائلة، ولأن الجريمة المنظمة ترى فيها فرصة مثالية لتبييض الأموال.
التهريب استوعب هذه المعادلة بالكامل. في الأسواق، تتزايد حصة السلع القادمة من مسارات مجهولة أو متعمد إخفاؤها. مواد غذائية، أجهزة كهرومنزلية، نسيج، محروقات: القائمة طويلة. هذه التدفقات لا تمر عبر الديوانة ولا عبر الحسابات البنكية. تُدفع نقدًا، تُعاد توزيعها نقدًا، وتُخزَّن نقدًا. في هذا السياق، يصبح القانون عائقًا، والالتزام عبئًا.
الكلفة الجبائية ثقيلة. خسائر الدولة تُقدَّر بعشرات مليارات الدنانير على امتداد سنوات، بين معاليم ديوانية غير مستخلصة وضرائب مُتهرَّب منها. لكن ما هو أخطر من العجز المالي، هو تشوّه بنية الاقتصاد نفسها. المواطنون الملتزمون بالقواعد يُسحقون أمام منافسة لا تتحمّل ضرائب ولا أعباء. الاقتصاد المنظم ينكمش، غير المنظم يزدهر، والحلقة المفرغة تترسخ.
هذا الواقع ليس جديدًا ولا مخفيًا. رئيس الجمهورية تطرّق إليه مرارًا بوصفه مسألة سيادة. لأن اقتصادًا يهيمن عليه النقد هو اقتصاد يصعب حكمه. يفلت من الإحصاء، ومن التخطيط، ومن التوجيه. يجعل السياسات العمومية شبه عمياء.
في هذا الإطار، انفجار السيولة ليس حادثًا عرضيًا. إنه وقود منظومة تعيد إنتاج نفسها. كلما دار النقد أكثر، تمدد الاقتصاد غير المنظم. وكلما تمدد غير المنظم، أصبح النقد أكثر ضرورة. وفيما تستقر هذه الحلقة، يحدث تحول آخر بصمت: توجيه هذه الأموال نحو ملاذات يُفترض أنها تحميها من التآكل. وفي مقدمتها، العقار.
العقار: الخزنة الصامتة لأموال الاقتصاد الموازي
عندما يعجز المال عن تبرير مصدره، يبحث عن مخبأ. في تونس، لهذا المخبأ اسم واحد: العقارات. منذ سنوات، لم يعد القطاع العقاري مجرد نشاط اقتصادي. تحوّل إلى آلية لتخزين القيمة، منفصلة عن الوظيفة الاجتماعية للسكن وعن واقع المداخيل.
الأرقام واضحة. قرابة مسكن واحد من كل خمسة اليوم شاغر أو يُستعمل كمقر ثانوي. بالأرقام المطلقة، نتحدث عن مئات الآلاف من الوحدات الخارجة فعليًا عن سوق السكن الحقيقي. وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار العقارات الارتفاع، متجاوزة بكثير القدرة الشرائية لغالبية التونسيين، بما في ذلك الفئات التي كانت تُعد تقليديًا ميسورة ضمن الطبقة الوسطى العليا.
هذا التناقض — وفرة العرض مقابل ندرة النفاذ — ليس لغزًا اقتصاديًا. إنه العرض الكلاسيكي لأصل تحوّل إلى خزنة. لم يعد العقار يُشترى للسكن، بل للحيازة. يمتص السيولة، يجمّدها، ويحميها من التضخم ومن رقابة البنوك. في اقتصاد تهيمن عليه السيولة، تصبح العقارات الامتداد الطبيعي للاقتصاد الموازي. وفوق ذلك، يعمل السماسرة والمطورون العقاريون بطبيعتهم خارج القنوات البنكية.
التحذيرات المؤسساتية ليست جديدة. منذ 2019، نبّهت لجنة التحاليل المالية إلى استغلال القطاع العقاري لأغراض تبييض الأموال. هذا القلق تعزّز لاحقًا، خصوصًا بشأن الصفقات المدفوعة نقدًا، والعقارات غير المأهولة، والشركات العقارية الغامضة. لم يعد الأمر هامشيًا، بل بات بنيويًا.
الأخطر أن هذه الفقاعة العقارية لا تقوم أساسًا على القروض البنكية، كما في أزمات عقارية أخرى. هي ممولة بالسيولة. وهذا ما يجعلها أصعب رصدًا، وأكثر خطورة. طالما يستمر تدفق الأموال، تبقى الأسعار صامدة. لكن في اليوم الذي يجف فيه هذا التدفق — بسبب صدمة نقدية، أو تدهور حاد في قيمة العملة، أو فقدان ثقة البنوك الدولية — قد يكون الأثر عنيفًا، دون أي صمام أمان.
لهذا النموذج كلفة اجتماعية مباشرة. العائلات الشابة تُقصى من حق السكن. المساحات القابلة للعيش تتقلص. يتخلى العقار عن دوره كأداة اندماج، ليصبح عامل تفكك. ما كان يفترض أن يكون ركيزة استقرار يتحول إلى مصدر ظلم وتوتر اجتماعي.
عند هذه المرحلة، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت هناك فقاعة عقارية، بل لماذا يتم التسامح معها. والأهم، من المسؤول داخل البنية المؤسساتية عن مراقبة الكتلة النقدية التي تغذي هذه الانحرافات.
البنك المركزي: حين تتحول الاستقلالية إلى نقطة ضعف
في هذه المرحلة، مواصلة الحديث عن “انحراف نقدي” دون توجيه الاتهام إلى المؤسسة التي تتحمل المسؤولية المباشرة هو ضرب من الجبن. نتحدث عن البنك المركزي التونسي وهو، بحكم تعريفه، حارس الاستقرار النقدي. هو من يتحكم في إصدار الأوراق النقدية، وفي تداولها، وفي إتلاف الأوراق الرثّة. يراقب التدفقات، ينتج المؤشرات، يعرف كل شيء. لكنه لا يقول شيئًا، ولا يفعل شيئًا.
الوقائع واضحة. كتلة الأوراق النقدية المتداولة بلغت مستوى غير مسبوق، لا علاقة له بالنمو الحقيقي للاقتصاد، ولا بتطور الإنتاج الوطني. هذا التوسع في السيولة لم يرافقه أي نقاش عمومي واضح، ولا أي شرح بيداغوجي موجّه للمواطنين. ترسّخ في صمت، وكأنه أمر بديهي.
هنا تحديدًا تطرح استقلالية البنك المركزي التونسي إشكالًا حقيقيًا. فقد صُمّمت لحماية السياسة النقدية من الضغوط السياسية قصيرة المدى، لكنها تبدو اليوم كأنها تحولت إلى حاجز. حاجز تُتخذ خلفه خيارات مصيرية، ذات كلفة ثقيلة قد تمتدّ لأجيال، دون محاسبة فعلية، وباسم كلاسيكية نقدية موجهة أساسًا للخارج.
البنك المركزي يتمتع بمصداقية شبه تلقائية لدى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف. هذه المصداقية تقوم جزئيًا على معطى تقني: الدينار التونسي يُطبع لدى مؤسسات أوروبية معترف بها، خاصة في فرنسا وألمانيا. بالنسبة للمراقبين في الخارج، تبدو السلسلة مطمئنة. يسألون المطبعة، يطّلعون على التقارير، ويأخذون كلام البنك المركزي على محمل الحقيقة.
لكن هذه الثقة الأجنبية لا تقول شيئًا عن الواقع الداخلي. لا تقول شيئًا عن جودة الأوراق النقدية التي يُعاد ضخها في التداول، ولا عن مدة استعمالها الفعلية، ولا عن الخط الفاصل — الذي أصبح ضبابيًا — بين الإتلاف القانوني وإعادة ضخ أوراق نقدية بالية. حين تواصل أوراق خارج المعايير الخروج من الموزعات الآلية والتداول بكثافة، تصبح المسألة سياسية بامتياز.
جوهر الاتهام هنا واضح: بتركه اقتصادًا مشبعًا بالسيولة يتمدد دون كبح، يخاطر البنك المركزي بخلق فقاعة نقدية غير مرئية للشركاء الخارجيين، لكنها مدمّرة للبلاد. يروّج لوهم الاستقرار، في حين يضرب القدرة الشرائية على المدى القصير، ويقوّض السيادة المالية للدولة التونسية على المدى الطويل.
الأسوأ أن هذا الوضع يخلق ريعًا جديدًا — وكأن تونس لا تعاني ما يكفي من الاقتصاد الريعي. في اقتصاد تتدفق فيه السيولة دون رقابة حقيقية، يُمنح بعض الفاعلين الخواص امتيازًا موضوعيًا. يصلون إلى النقد، يوجّهونه، يحولونه إلى أصول، فيما تتحمل العائلات العادية التضخم، وارتفاع الأسعار، والتآكل التدريجي لمداخيلها ومدخراتها.
لا يمكن للبنك المركزي أن يجهل هذه الآثار. وإن تجاهلها، فذلك يعني أنه اختار تفضيل الامتثال الشكلي للمعايير الدولية على حساب الاستقرار الحقيقي للاقتصاد التونسي. في الحالتين، المسؤولية — بل الذنب! — ثابتة.
عرفت تونس أزمات من قبل. لكن الفارق اليوم جوهري: لم تعد تملك احتياطات من العملة الصعبة، ولا هوامش دبلوماسية، تسمح بامتصاص صدمة كبرى كما في السابق. في حال حدوث قطيعة مفاجئة، لن يكون الأثر بطيئًا ولا متدرجًا. سيكون حادًا.
عند هذه النقطة بالذات، تتوقف المقارنة مع التجارب الأجنبية عن كونها مجرد صيغة صادمة، لتصبح فرضية جدّية.
قنبلة مالية موقوتة: لماذا لم يعد السيناريو اللبناني في تونس مجرد فرضية
المقارنة مع لبنان تزعج لأنها تُجبر على النظر إلى مسار، لا إلى حدث معزول. الأزمات المالية النظامية لا تبدأ بانهيار مفاجئ. تبدأ بتطبيع تدريجي للاختلالات، بإشارات ضعيفة يتم تجاهلها، وباختلالات مصطنعة يُسمح لها بالاستمرار طويلًا.
في تونس، اجتمعت اليوم عدة من هذه المؤشرات. كتلة سيولة متداولة غير متناسبة مع حجم الاقتصاد. انفصال متزايد بين قيمة الأصول — وخاصة العقارية — والمداخيل الحقيقية. اقتصاد غير منظم مهيمن يفلت من التوجيه المؤسساتي. والأخطر، وهم استقرار تُغذّيه مؤشرات شكلية (قيمة الدينار، أسعار السلع) تُخفي هشاشة المنظومة النقدية.
الاختلاف الجوهري مع أزمات الماضي يرتبط بعامل حاسم: هامش الحركة الخارجي. بين 2008 و2012، كانت تونس لا تزال تمتلك احتياطات من العملة الصعبة تسمح بامتصاص جزء من الصدمة، وباستقرار العملة، وبكسب الوقت. اليوم، هذه الاحتياطات لا تغطي سوى بضعة أشهر من الواردات. لم تعد درعًا، بل مجرد وسادة، تُستهلك بسرعة عند أول ازمة نقدية أو فقدان ثقة من المؤسسات الدولية.
في هذا السياق، آلية الخطر واضحة. طالما النقد يدور، تبقى الفقاعة قائمة. وطالما العقار يمتص السيولة، يستمر وهم الثراء. لكن في اليوم الذي تتصدع فيه الثقة — بفعل تدهور متسارع في قيمة الدينار، أو صدمة خارجية، أو انكشاف الحجم الحقيقي للخلق النقدي — قد يكون الارتداد عنيفًا. تنهار قيمة الأصول، تتآكل القدرة الشرائية، وتجد الدولة نفسها بلا أدوات فعالة لكبح الدوامة.
الأكثر إثارة للقلق أن هذه الأزمة، إن اندلعت، لن تكون في بدايتها أزمة بنكية. ستكون نقدية واجتماعية. ستضرب الأسر، الأجراء، صغار المدخرين، قبل أن تصل إلى من سبق لهم تحويل السيولة إلى أصول عقارية أو تأمين أنفسهم في الخارج. وهذا بالضبط ما يجعل هذا النوع من الأزمات قابلًا للانفجار سياسيًا.
لذلك، الحديث عن “قنبلة مالية” ليس مبالغة لغوية. هو توصيف لمسار من الوقائع القابلة للرصد، الموثقة، والتي باتت شروط تكرارها متوفرة اليوم. الخطر ليس أن السيناريو اللبناني حتمي في تونس. الخطر أن يصبح ممكنًا.
السؤال لم يعد “هل”، بل “متى” — والأهم، هل ستُتخذ قرارات شجاعة قبل أن تنفلت الآلية من عقالها. لأن الثقة، حين تُفقد لدى المؤسسات المالية، لا تعيدها أي استقلالية مؤسساتية، ولا أي خطاب مطمئن، ولا أي لغة تكنوقراطية.
حين يتعفّن المال، تتزعزع الدولة
لن يكون هناك إعلان رسمي. لا بيانًا، ولا تاريخًا محددا في الروزنامة. الأزمات الكبرى لا تُنذر بقدومها. هي تستقرّ. تتقدم بصمت، إلى أن تحدث ثم يتظاهر الجميع بالدهشة.
البنك المركزي يلعب بالنار. نار بطيئة، غير مرئية، يغذيها النقد، يحرسها الصمت، وتحميها استقلالية مؤسساتية تحولت إلى لا مسؤولية سياسية. حين تدور العملة أسرع من الإنتاج، وحين يحلّ العقار محلّ العمل، وحين تنكمش الاقتصاديات الحقيقية بينما تهترئ الأوراق النقدية وتشيخ، لا نكون أمام خلل عابر. نكون أمام مسار مقصود.
الأخطر ليس أن يثرى بعضهم. الأخطر أن يُساق بلد بأكمله إلى وهم جماعي: وهم استقرار زائف، مُموّل بالدَّين من مستقبل أبنائنا وأحفادنا. وهم تُطمئن فيه المؤسسة النقدية الخارج، بينما يتفكك الداخل. ويدفع فيه المواطنون التونسيون والدولة الفاتورة.
اقتصاد لبنان لم يسقط في يوم واحد. انزلق ببطء. إلى أن صارت العملة لا تساوي الورق الذي طُبعت عليه، وتبخرت المدّخرات، وحلّ الغضب محلّ الخوف. الذين ظنوا أنفسهم في مأمن اكتشفوا أنه لا وجود لخزنة آمنة في اقتصاد ينهار.
لم يعد السؤال ما إذا كانت تونس في خطر. هي في قلب الخطر فعلًا. السؤال هو من سيملك الجرأة لكسر هذه الآلية قبل أن تنفجر. لأن قنبلة المال، حين تنفجر، يكون دائمًا قد فات الأوان للمحاسبة. يدفع الثمن دائمًا الأبرياء، ونادرًا ما يُسأل المذنبون.