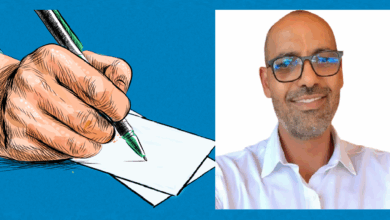نزار الجليدي يكتب لكم/2026 : شريعة الغاب… وعالم ما يزال يستهين بترامب!!


في عام واحد من ولايته الثانية، أعاد دونالد ترامب القوة الصلبة كمنطقللجغرافيا السياسية العالمية: ابتزاز تجاري، تهديدات إقليمية، وضغوط مباشرة لا يكلّف نفسه عناء إخفائها. ومع ذلك، ما تزال دول كثيرة، في أوروبا كما في الجنوب العالمي، تتعامل مع هذه الإشارات كنزوات عابرة أو تجاوزات خطابية مؤقتة. هذا خطأ في القراءة. القاعدة الجديدة باتت واضحة وبسيطة: السيادة تساوي الثمن الذي تستطيع الدول فرضه على الولايات المتحدة. وبينما تنهمك أوروبا في النقاشات، تستعدّ الصين للعاصفة، فيما تقف إفريقيا، كالعادة، على حافة الصدمة من دون استعداد حقيقي.
هناك لحظات يتسارع فيها التاريخ، لا عبر الخطب الطويلة، بل من خلال سلسلة أفعال قصيرة تغيّر ميزان القوى. خلال اثني عشر شهرًا من ولايته الثانية، لقّن ترامب العالم درسًا يرفض كثيرون استيعابه: القوانين لا توقف أحدًا حين يكون ميزان القوة مختلًا. التحالفات لا تملك قيمة ذاتية؛ قيمتها مرهونة بمصلحة “الراعي”. وما إن يقرّر هذا الأخير تسعير حمايته، حتى تتحوّل الدبلوماسية إلى سلسلة من الإهانات، وتغدو السيادة بندًا تفاوضيًا، وتصبح الجغرافيا عملة.
قضية غرينلاند نموذجية تحديدًا لأنها لا تتعلق بعدو للولايات المتحدة. هنا يطرح ترامب منهجًا عاريًا من الزخرفة: إجراء تجاري — الرسوم الجمركية — يُستخدم أداة للضغط الإقليمي. ليست المسألة استفزازًا للدنمارك فحسب، بل رسالة مباشرة إلى أوروبا بأكملها. في بيتوفيك، على الجزيرة، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري محدود عدديًا لكنه بالغ الدلالة، في حدود 150 عنصرًا، مع بنية تحتية تذكّر بحقيقة قاسية: القطب الشمالي لم يعد مشهدًا جليديًا رومانسيًا، بل عمقًا دفاعيًا، وزاوية إسقاط عسكري، ومعادلة إنذار ومراقبة.
في الوقت نفسه، كشف المسرح الآخر لبداية 2026 — فنزويلا — حقيقة ثانية: القوة قد تضمن العناوين الصحفية، لكنها لا تضمن الأرباح. ظنّت واشنطن أنها بضرب كاراكاس واختطاف رئيسها أمسكت بورقة طاقة وسياسة حاسمة. غير أن لا شيء يضمن استقرارًا يخدم المصالح الأمريكية في فنزويلا، كما أن ميكانيكا النفط لا تخضع للشعارات. صحيح أن فنزويلا تملك نظريًا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطي، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الثروة يتكوّن من نفط فائق الثقل، صعب المعالجة، عالي الكلفة، وذي كثافة منخفضة جدًا. الواقع يُقرأ في التدفقات: الشحنات دارت حول 934 ألف برميل يوميًا، منها نحو 503 آلاف برميل متجهة إلى الصين. الخلاصة واضحة: الاقتصاد العالمي يتكيّف، المسارات يعاد رسمها، ومن يعتقد أنه “استولى” على سوق ما بقوة السلاح، يجد نفسه أحيانًا مموّلًا لتكاليف التكرير بدلًا من جني الأرباح.
هنا تبرز الصفيحة التكتونية الثالثة: الصين. حيث يرى كثيرون صراع غرور، ترى بكين خللًا بنيويًا في الهندسة الاستراتيجية. هاجس شي جين بينغ ليس الردّ الفوري، بل منع أي خنق بحري منفرد من التحوّل إلى حكم بالإعدام على اقتصاد بلاده النشيط. الأرقام كاشفة: في 2025، استوردت الصين نحو 557.7 مليون طن من النفط الخام، أي ما يقارب 11.55 مليون برميل يوميًا، وواصلت في الوقت نفسه ملء مخزوناتها بمعدل وسطي يقارب 430 ألف برميل يوميًا. هذا ليس نزوة، بل سياسة صمود محسوبة. والولايات المتحدة تدرك ذلك إلى حد بعيد، وهو ما يفسّر جزئيًا التصعيد المتدرّج تجاه إيران.
هذا المنطق يمتدّ على الخريطة. الممرات الطاقية واللوجستية الصينية ليست أوهامًا نظرية؛ بعضها قائم، موثّق، ويعمل كصمّام أمان. خط أنابيب النفط بين الصين وميانمار تُقدّر طاقته القصوى بنحو 22 مليون طن سنويًا، أي في حدود 440 ألف برميل يوميًا إذا استُخدم بالكامل. الغاز يسير على المنوال نفسه، بطاقة تُقدَّر غالبًا بنحو 12 مليار متر مكعب سنويًا. هذا لا يلغي الضغط البحري الأمريكي في بحر الفلبين وبحر العرب، لكنه يخفّفه. إنه هامش سيادي إضافي.
هذا التباين هو مفتاح القراءة: من جهة، أمريكا تتبنّى العنف بوصفه لغة كونية صريحة؛ ومن جهة أخرى، الصين ترتّب هوامشها، ومخزوناتها، ومناطقها العازلة، ومساراتها البديلة. بين الطرفين، ما تزال أوروبا وجزء واسع من الدول النامية تفسّر هذه الإشارات على أنها مسرحية سياسية. إنها تخطئ في تحديد اللحظة التاريخية، وتستخفّ بترامب. نحن ندخل مرحلة تُنتج فيها الخشية قرارات غير عقلانية، وتصبح فيها الحيادية مكلفة، وتكتشف فيها الدول التي لا تملك عمقًا استراتيجيًا ولا أدوات ضغط، وبصورة فجئية، أنها لم تعد تملك أي خيار.
التحوّل الحاسم: حين يحلّ التهوّر محلّ القوة
ما جرى خلال عام واحد ليس سلسلة أزمات متفرّقة، بل تحوّل جذري في طريقة الفعل. القانون الدولي لم يختفِ، لكنه كفّ عن أداء دور الحاجز. عاد ليكون لغة انتقائية: يُستدعى حين يخدم مصلحة امريكا، ويُهمَل حين يقيّدها. ترامب لم يخترع هذا السلوك، لكنه جعله صريحًا، فجًّا، ومعلنًا بلا مواربة.
الابتزاز التجاري الذي فُرض على حلفاء أوروبيين يمثّل قطيعة واضحة مع الممارسات السابقة. فرض رسوم بنسبة 10%، ثم التلويح برفعها إلى 25%، لا بهدف تصحيح اختلال تجاري، بل لانتزاع هدف جيوسياسي محدّد — “شراء” غرينلاند — يندرج ضمن منطق الاستفزاز الخالص. الرسالة لا تحتمل التأويل: الوصول إلى السوق الأمريكية لم يعد حقًا نابعًا من التحالفات أو المعاهدات، بل امتيازًا مشروطًا. الأمن بات سلعة قابلة للفوترة. والولاء، موضوع مساومة.
هذه المقاربة لا تقتصر على أوروبا. إنها تعيد رسم الهرمية العالمية برمّتها. الدول القادرة على فرض كلفة استراتيجية لا ترغب واشنطن في تحمّلها تستطيع التفاوض. أمّا البقية، فتُجبر على الامتثال. القانون يتدخّل لاحقًا، للتعليق أو الإدانة أو التأريخ. أمّا القرار الحقيقي، فيُتخذ مسبقًا، وفق حساب بسيط: “من يستطيع إيقافي، وبأي ثمن؟”.
المنطق نفسه يحكم الملفات الطاقية والعسكرية. لم تُستهدف فنزويلا لما هي عليه، بل لما تمثّله في المخيال الأمريكي للقوة: احتياطي يُفترض أنه حاسم، دولة قابلة للعزل، ورمز للسيطرة الممكنة على المنطقة. غير أن الواقع كشف حدود هذا التصوّر. الأسواق امتصّت الصدمة. التدفقات أعيد توجيهها. الكلفة تفرّقت على أطراف متعددة. القوة أحدثت ضجيجًا، لا هيمنة مستدامة. حتى وإن كانت الدول المعتمدة على الاستيراد ستدفع، فعليًا، ثمن ما جرى في كاراكاس.
لهذا التحوّل أثر مباشر: إعادة الاعتبار للجغرافيا بوصفها هدفا. الأراضي تعود لتكون جائزة، لا بسبب ما تنتجه فورًا، بل بسبب ما تتيحه من إغلاق، مراقبة، أو إسقاط قوة. القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، المضائق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، خطوط الأنابيب بالنسبة للصين… الممرّات البرية تستعيد مركزية كان كثير من الدبلوماسيين قد همّشوها. ويتجلّى ذلك بوضوح في الاستخفاف الإعلامي بملفات مثل سوريا، مالي، الكونغو، أو مؤخرًا، انفتاح منغوليا على عدة دول غربية.
الدول التي لا تملك عمقًا استراتيجيًا، ولا قدرة إضرار، ولا هامش مناورة اقتصادي، تجد نفسها مكشوفة. الخطأ الأكثر شيوعًا يتمثّل في الاعتقاد بأن هذه المرحلة عابرة، مرتبطة برجل أو بأسلوب. هي ليست كذلك. ما يفعله ترامب — أو ما يسرّعه — ليس سوى امتداد لما فعله بايدن وأوباما قبله. السياق التاريخي أوسع: إعادة تركيب للنظام الدولي، تُمارَس فيها القوة من دون السعي إلى شرعنة كونية.
وكل ذلك يجري وسط تصفيق جمهور فقد حسّه بالعواقب، وأصيب بعمى استراتيجي، وبفقدان ذاكرة تاريخية. ترامب ليس استثناءً ولا حادثًا عابرًا. هو مُحفِّز. يؤدي وظيفته بوضوح: تأمين مستقبل للإمبراطورية الأمريكية من دون الركيزة القديمة لهيمنة الدولار.
غرينلاند: القطب الشمالي كمختبر للعنف الجيوسياسي
عبارة “شراء غرينلاند” ليست نزوة عابرة. إنها تجربة. في هذا الملف، طبّق ترامب منهجًا بات يوسّعه اليوم على مستويات أخرى: تحويل مسألة أمنية إلى أداة ابتزاز اقتصادي مباشر. كون الهدف حليفًا لا خصمًا يجعل العملية أكثر دلالة. المسألة لا تتعلّق بمعاقبة عدو، بل بإعادة تأديب أوروبيين توهّموا أنهم يمتلكون سيادة كاملة.
عسكريًا، الاهتمام الأمريكي بغرينلاند قديم ومُوثَّق. قاعدة بيتوفيك، الوريثة المباشرة لثول، لا تزال حلقة محورية في منظومة الإنذار المبكر والدفاع المتقدّم لأمريكا الشمالية منذ الحرب الباردة. ورغم محدودية الوجود البشري — نحو 150 عسكريًا — فإن البنية التحتية مصمّمة لوظائف تتجاوز الروتين: مراقبة فضائية، إنذار صاروخي، والتحكّم بمحور قطبي يستعيد مركزيته كلما انحسرت الكتل الجليدية. القطب الشمالي لم يعد هامشًا متجمّدًا؛ لقد أصبح ممرًا استراتيجيًا مفتوحًا.
ما تغيّر مع ترامب ليس الاهتمام، بل الأسلوب. حيث كانت واشنطن تتحدّث سابقًا عن تحالفات، ومسؤوليات مشتركة، وأمن جماعي، أصبح الخطاب اليوم تجاريًا صرفًا. الرسوم الجمركية المُعلَن عنها ضد عدد من الدول الأوروبية ابتداءً من فيفري لا تهدف إلى تصحيح اختلال تجاري. هدفها انتزاع تنازل جيوسياسي جوهري. الأرض نفسها تتحوّل إلى متغيّر قابل للمساومة. وفي الأثناء، يتصرّف الإعلام الأوروبي إمّا بدهشة مصطنعة، أو بسخرية عابرة — وكلاهما عجز مقنّع.
بالنسبة لأوروبا، الرسالة قاسية. فهي تكتشف أن اندماجها الاقتصادي، الذي طالما اعتُبر مصدر قوة، يمكن أن ينقلب إلى نقطة ضعف. اعتمادها على الوصول إلى السوق الأمريكية — وعلى الموارد التي تتحكّم بها واشنطن — يتحوّل إلى رافعة ضغط قابلة للتفعيل في أي لحظة. وعجز أوروبا عن فرض كلفة مقابلة يعرّي اختلالًا استراتيجيًا لا تستطيع البيانات الدبلوماسية التستّر عليه.
غرينلاند تؤدّي هنا دور الإنذار الأخير، أو بالأحرى “الجولة الشرفية” الأمريكية. إنها تُظهر أن الأمن الغربي لم يعد منفعة مشتركة، بل خدمة يمكن تسعيرها. كما تؤكد أن الجغرافيا، في هذا العالم الجديد، خرجت من سجلّ القانون والتاريخ، ودخلت سجلّ موازين القوة. من يمتلك السلاح ولا يتردّد في استخدامه، هو من يفرض الشروط.
هذا المختبر القطبي يعلن ما هو آتٍ. فإذا كان بالإمكان إخضاع حليف لابتزاز سيادي على أرضه، فلا دولة مرتبطة بالولايات المتحدة يمكنها الادعاء بأنها في مأمن. السؤال لم يعد إن كانت هذه المنهجية ستتوسّع، بل أين، وبأي وتيرة.
فنزويلا: الوهم النفطي وحدوده
شكّلت فنزويلا اختبارًا ميدانيًا واسع النطاق. أسقطت واشنطن عليها قناعة قديمة، تكاد تكون ساذجة: السيطرة السياسية على دولة غنية بالمحروقات تعني امتلاك وسيلة ضغط جيوسياسية حاسمة. غير أن واقع النفط أكثر تمرّدًا. فهو لا يخضع للخطابات ولا لإعلانات القوة، بل للكيمياء، والبنية التحتية، وحسابات السوق.
على الورق، تمتلك فنزويلا أكثر من 300 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، رقم صادم يغذّي أوهام الهيمنة. لكن هذه الوفرة مضلِّلة. جزء كبير من هذه الكميات يتكوّن من نفط فائق الثقل، مرتفع الكلفة في الاستخراج، شديد الاعتماد على المذيبات، ويتطلّب قدرات تكرير متخصّصة. هذا ليس نفطًا يفرض نفسه بمجرد امتلاك باطن الأرض. بل يحتاج إلى منظومة صناعية وأسواق قادرة على استيعاب تعقيده. وكل ذلك دون احتساب الكلفة السياسية.
التدفّقات هي التي تروي القصة الحقيقية. خلال العام الماضي، قاربت الصادرات الفنزويلية 934 ألف برميل يوميًا. الصين وحدها استوعبت نحو 503 آلاف برميل، مؤكدة حقيقة يتعمّد كثيرون تجاهلها: بكين لم تكن يومًا أسيرة مورّد واحد. البراميل تتحرّك، والمسارات تعاد هندستها، وحين تغيّر العقوبات أو الضربات القسرية مسارًا ما، يجد السوق بدائل. الهند، إسبانيا، وأحيانًا حتى الولايات المتحدة نفسها أعادت ضبط مشترياتها. منتجو أوبك الوسيطون سدّوا الفجوات. الأسعار استقرّت — ولكن لصالح القوى الكبرى فقط.
المفارقة قاسية على واشنطن، التي وجدت نفسها في فخ. العملية صنعت عناوين صحفية، لا سيطرة مستدامة. الكلفة التقنية للنفط الثقيل تسرّبت إلى المستهلك الأمريكي، بينما ذهب العائد الفعلي إلى من يملكون أصلًا قدرات التكرير المناسبة: الصين. الوهم كان الاعتقاد بأن إسقاط نظام يمكن أن يتحوّل تلقائيًا إلى مكسب اقتصادي. لكن هنا أيضًا، اصطدمت الولايات المتحدة بحدودها. النفط أعاد تذكير الجميع بقاعدة أولية: القوة لا تلغي القيود الصناعية.
الحالة الفنزويلية تُنير ما وراءها. تُظهر أن القوة قد تُربك، لكنها نادرًا ما تبني سلاسل قيمة معقّدة. وتُثبت أن من استبق — بتنويع مصادره، وتكييف أدواته، وبناء مخزونه — امتصّ الصدمة. أما من يرتجل، فيكتشف حدود قدراته.
الصين: التحضير الرصين في مواجهة الوحشية الأمريكية
لا يكمن الفرق بين الولايات المتحدة والصين في الخطاب، بل في العلاقة مع الزمن. حيث يضرب ترامب ليُحدث أثرًا فوريًا، يعمل شي جينبينغ على توسيع هوامش بلاده كي تصمد في عالم غير مستقر. الصين لا تتجاهل الاندفاع الأمريكي ولا عنف أسلوبه. بل تنطلق من فرضية أنهما دائمان.
هشاشة بكين معروفة، وغالبًا ما تُختزل في أسماء موانئ نادرًا ما تكون على الأراضيالصينية: ملقا، رانغون، كلانغ، بانكوك… جزء ساحق من واردات الصين الطاقية يمر عبر مضائق ضيقة، سهلة المراقبة، وقابلة نظريًا للإغلاق في حال أزمة كبرى. الصين لا تنكر هذا الخطر. بل تعالجه. في عام 2025، استوردت الصين نحو 557.7 مليون طن من النفط الخام، أي ما يقارب 11.55 مليون برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، واصلت ملء مخزوناتها الاستراتيجية بمعدل وسطي يقارب 430 ألف برميل يوميًا. هذا دون احتساب الواردات القادمة من إيران وروسيا، التي لا يمكن لأحد تقديرها بدقة. هذا التحرك المزدوج — استيراد أكثر وتخزين أكبر — ليس اندفاعًا أعمى. إنه تأمين للمستقبل.
الردّ الصيني لا يقتصر على الأرقام. إنه جغرافي. الممرات البرية لا تعوّض البحر، لكنها تقلّص الارتهان لنقطة اختناق واحدة. خط أنابيب النفط بين الصين وميانمار، بطاقة قد تصل إلى 22 مليون طن سنويًا، يوفر متنفسًا يعادل مئات آلاف البراميل يوميًا. الغاز يسير على المنطق نفسه، بطاقة سنوية تقارب 12 مليار متر مكعب. هذه الكميات لا تكفي وحدها لحمل الاقتصاد الصيني، لكنها تغيّر الحسابات في زمن الأزمات — كما حدث، صدفةً ليست بريئة، مع اختطاف رئيس الدولة الفنزويلية على يد الولايات المتحدة.
إلى جانب هذه الممرات، بنت الصين مناطق عازلة استراتيجية. ثنائية باكستان – إيران تشكّل عمقًا عسكريًا ولوجستيًا يؤمّن الوصول إلى المحيط الهندي. شرقًا، يخلق قوس ميانمار – بنغلادش – نيبال هوامش حركة، ومسارات بديلة، وخيارات عسكرية وتجارية. لا شيء استعراضيًا. كل شيء تراكمي. الصين لا تسعى إلى تحدي القوة الأمريكية مواجهةً مباشرة، حتى وإن كانت مستعدة لذلك أكثر مما يُظن. هي تسعى إلى ضمان ألا تكون أي ضربة قاتلة.
هذا الخيار يفسّر أيضًا لماذا لم تُنتج الضربات الموجهة إلى فنزويلا الأثر المتوقع. شي جينبينغ لا ينتظر سقوط شريك كي يتحرّك. الصين تُكيّف مصافيها، تقلّص حصة النفوط الثقيلة في وارداتها، تنوّع شركاءها، وتستثمر في التخزين. وعندما تصل القوة، تصطدم بمنظومة جرى امتصاص الصدمة فيها مسبقًا.
هنا يتّسع الفارق مع أوروبا وجزء من العالم النامي. بينما لا يزال بعضهم يفكّر بلغة المعايير وحسن النوايا، تفكّر الصين بالقدرات، والمسارات، والمخزونات، والعمق الاستراتيجي. في هذه الغابة التي أصبحها العالم، لا تدّعي الصين الفضيلة. بل تقلّل قابليتها للكسر.
الخاسرون الكبار: أوروبا وأفريقيا في مواجهة الانعطافة التاريخية
أصبح التباين اليوم صارخًا. من جهة، قوى استوعبت نهاية القواعد — أو ما يُسمّى مجازًا “القانون الدولي” — وجعلت من تجاوزها إطارًا للفعل. ومن جهة أخرى، مناطق لا تزال تعتقد أن القوة يمكن ترويضها بالقانون، وأن التاريخ يتحرك بالقصور الذاتي. في هذا التوازن الجديد، تبدو أوروبا وأفريقيا الأكثر عرضة للكسر.
أوروبا أولًا.
تكتشف القارة أن ازدهارها كان قائمًا على افتراضات سقطت: أمن مفوَّض للولايات المتحدة، طاقة وفيرة (نُهبت من أفريقيا أو استوردت من روسيا)، وصول مضمون إلى الأسواق (الأمريكية، ودول البلطيق، والمغرب العربي، وغرب أفريقيا، والكاريبي خصوصًا). أزمة الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ثم الابتزاز الجمركي الأمريكي، كشفت تبعية أوروبية عميقة.
الاتحاد الأوروبي لا يمتلك قدرة إزعاج استراتيجية حقيقية، ولا استقلالًا طاقيًا كافيًا، ولا تماسكًا سياسيًا يمكّنه من فرض كلفة ملموسة على الإهانات المتتالية التي يفرضها ترامب. عندما تهدد واشنطن بإغلاق سوقها أو بفرض رسوم عقابية، لا يملك الأوروبيون أداة رد مماثلة. يفاوضون، يماطلون، يناورون… لكنهم لا يردعون.
تزداد هذه الهشاشة بفعل قراءة خاطئة للحظة التاريخية. عدد كبير من الدول الأوروبية لا يزال يتعامل مع الإشارات الأمريكية بوصفها شطحات أسلوبية، أو مواقف انتخابية، أو تكتيكات تفاوض. لا يراها كعقيدة سياسية. وهذه بالضبط هي الغلطة التي تضعها في موقع الضعف. في عالم تُمارَس فيه القوة بلا حاجة إلى تبرير معياري، يصبح الانتظار استراتيجية خاسرة. أما خطاب الضحية، فسيكلّف أكثر — لكن ذلك سيظهر قريبًا.
أفريقيا ثانيًا.
القارة تقف عند تقاطع كل الضغوط: موارد طاقية ومعدنية مطلوبة، دول هشة في كثير من الأحيان، تبعية مالية وأمنية مستمرة. هيمنة منطق القوة لا تترك أمامها سوى خيارات ضيقة.
الدول التي تمتلك موارد استراتيجية يمكنها أن تراهن على “اصطفاف مشروط”، تساوم على ثرواتها مقابل حماية أو استثمارات. هذا هو حال الكونغو الديمقراطية، وليبيا، ومصر مثلًا. أما البقية، فتواجه خطر الاستسلام الصامت: قبول شروط مجحفة، تقلّص الهوامش الدبلوماسية، وتعرّض متزايد للتدخلات الخارجية.
بين هذين القطبين، ستحاول بعض الدول تغيير بوصلتها الدبلوماسية: تنويع الشركاء، لعب التوازنات، شراء الوقت. لكن هذا المسار يتطلب وعيًا استراتيجيًا وتماسكًا سياسيًا لا يتوفران إلا نادرًا. الغموض مكلف، ونادرًا ما يصمد أمام اختبار الزمن.
ما يلفت في العمق هو تشابه نقاط الضعف الأوروبية والأفريقية، رغم اختلاف التاريخ ومستويات التنمية — بل ورغم تاريخ استعماري حديث في حالة أفريقيا. القارتان اعتقدتا طويلًا أن الاندماج في النظام الدولي يشكّل حماية. اليوم تكتشفان أن هذا النظام لم يعد شبكة أمان، بل ساحة صيد. وفي هذه الساحة، من لا يستطيع فرض كلفة لا تُحتمل على أمريكا، ولا تنظيم صموده، يتحول إلى فريسة سهلة.
القوى المحورية: حين يصبح اللايقين هو القاعدة
في هذا النظام العالمي المتقلب، تبرز قوى لا تزال تفلت من التصنيفات البسيطة. ليست مصطفّة بالكامل، ولا في مواجهة مباشرة. تتحول إلى قوى محورية قادرة على ترجيح موازين إقليمية كاملة. خياراتها غير ثابتة، بل تخضع لتوازنات اللحظة، ولسعر الأمن، ولمصداقية الشركاء.
دول الخليج العربي تمثل النموذج الأوضح. لعقود، ارتبطت بالمظلّة الأمنية الأمريكية. لكنها، تدريجيًا، أعادت توزيع أوراقها. حسابها ناضج ودقيق. من جهة، لا تزال الولايات المتحدة مزودًا أمنيًا عسكريًا لا يمكن الاستغناء عنه على المدى القصير. ومن جهة أخرى، أصبحت الصين وحلفاؤها زبائن طاقة أساسيين، ومستثمرين كبارًا، وشركاء صناعيين متصاعدين.
السعودية والإمارات، على سبيل المثال، لا تسعيان إلى القطيعة مع واشنطن. هما تسعيان إلى امتلاك الخيار الذي يسمح لهما بالتحكم في ساكن البيت الأبيض. الاصطفاف الحصري بات مخاطرة استراتيجية، وأسياد “أوبك” يدركون ذلك أكثر من غيرهم.
روسيا، بدورها، تحتل موقعًا أكثر التباسًا. ضعفت اقتصاديًا، لكنها ما زالت تمتلك قدرات عسكرية واستراتيجية معتبرة. وهي ليست محكومة بصدام دائم مع الغرب على عكس ما يظنه البعض. التجربة الحديثة تُظهر أن موسكو اعتادت التناوب بين القطيعة وإعادة الانخراط مع الغرب، متى اقتضت مصالحها ذلك. في سياق تفضّل فيه واشنطن الاستفزاز، لا يمكن استبعاد عودة تكتيكية لروسيا إلى بعض القنوات الغربية. لا بدافع القناعة، بل بدافع الحساب. في قانون الغابة، التحالفات المؤقتة ليست استثناءً.
أما تركيا، فهي على الأرجح الحالة الأكثر تقلبًا. تقع على تخوم أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتملك أوراقًا جغرافية وصناعية وتجارية ثقيلة، لكنها تعاني أيضًا من هشاشات داخلية. في أحد السيناريوهات، قد تفرض نفسها كقوة مركزية، تتحكم في تدفقات الطاقة والهجرة والأمن، وتصبح بحكم الأمر الواقع شريكًا لا غنى عنه لأوروبا عاجزة. وفي سيناريو آخر، قد تتعرض لضغط متزامن: أمريكي، أوروبي، وإقليمي، بما يفضي إلى تفكك سياسي أو اقتصادي. تركيا ليست محكومة بأحد المصيرين. مستقبلها سيتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا إلى قوة، لا إلى عبء.
هذه القوى المحورية تتقاسم سمة واحدة: أدركت أن الحياد السلبي لم يعد موجودًا. تتحرك عبر تعديلات محسوبة، وإشارات مدروسة، وإعادة انتشار تدريجية. لا تؤمن بالضمانات الأبدية. تستثمر في الشكوك حول المستقبل.
وهنا تكمن أكثر دروس اللحظة الراهنة أهمية. العالم لا يتجه إلى انقسام ثنائي ثابت. بل ينزلق نحو نظام سيّال، غير مستقر، حيث التحالفات قابلة للعكس، والولاءات مشروطة. من يواصل التفكير بمنطق المعسكرات الجامدة سيتفاجأ. أما من يقبل بأن القاعدة الجديدة هي التكيّف الدائم، فله فرصة لعبور العاصفة.
ما الذي ينفلت فعلًا ليس أزمة إضافية، بل انهيار صامت للقواعد القديمة
ما الذي بدأ بالتحرك ليس أزمة جديدة تُضاف إلى سجل الأزمات. إنّه انهيار صامت للقواعد التي كانت لا تزال تمنح العالم وهم نظام دولي قائم. خلال عام واحد، لم يحكم ترامب بطريقة مختلفة فحسب. لقد قال علنًا ما كان كثيرون يمارسونه همسًا: القوة هي الفيصل، الأرض قابلة للتفاوض، السوق يتحول إلى سلاح، والقانون لا قيمة له إلا ما دام لا يقيّد النفوذ.
الصدمة لا تأتي من واشنطن. بل من بطء بقية العالم في إدراك ما يحدث له. أوروبا ما زالت تتحدث وكأنها تملك خيارًا، بينما فقدت فعليًا استقلالها الطاقي، وقدرتها على الردع، وأي أداة اقتصادية ذات مصداقية في مواجهة الفظاظة الأمريكية. تفكّر بمنطق المعايير في عالم بات يحسب بالكلفة. وتكتشف متأخرة أن التبعية ليست وضعًا مريحًا، بل نقطة ضعف قابلة للاستغلال ولا رجعة فيها.
أما إفريقيا، فهي تتجه نحو عقد بالغ الخطورة. موارد مرغوبة، دول مفككة، وهوامش مناورة ضيقة. ليست حكمًا ولا متفرجًا. إنها الساحة نفسها. الدول الغنية بالنفط والغاز والمعادن ستحاول شراء الاصطفاف الأقل كلفة. أما البقية فستُسحق بالضغط العاري. والذين يظنون أنهم قادرون على البقاء خارج اللعبة سيكتشفون أن اللامبالاة قرار، وأن ثمنه باهظ.
في مواجهة هذا التشكل الجديد، لم تختر الصين الأخلاق. اختارت البقاء. طرق بديلة، مخزونات، ممرات، هوامش جغرافية، وتكييف صناعي. لا خطب رنّانة. لا دروس كونية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقط إعداد منهجي للخنق، للعقوبات، للقطيعة… للحرب ربما. بينما يحتج الآخرون، تمتص الصين الصدمة. بينما يندد غيرها، تعيد هيكلة نفسها وتستعد.
القوى المحورية فهمت ذلك منذ الآن. الخليج العربي يجعل نفسه لا غنى عنه، بطريقة تكاد تكون سويسرية. تركيا تتأرجح بين الصعود والانفجار، وكل شيء فيها معلق بشخص أردوغان، وهو ليس خالدًا. روسيا، رغم هشاشاتها البنيوية (الديموغرافيا، الضغوط الاقتصادية)، تظل خطِرة بما يكفي كي لا تُعامل أبدًا كدولة تابعة. في هذا العالم، الاصطفاف ليس نهائيًا، والولاء لا يُشترى إلا بثمن الاحترام أو الخوف.
عنف هذه اللحظة ينبع من حقيقة واحدة بسيطة: من لا يستطيع الردع، ولا العرقلة، ولا فرض كلفة، يتحول إلى موضوع تفاوض. سيادته تتشظى، تُباع، تُقضم. الغابة ليست فوضى. إنها نظام قاسٍ، هرمي، حيث الضعفاء لا تحميهم المبادئ، بل تفضحهم هشاشتهم.
الزلزال وقع بالفعل. وهو في بدايته فقط. والذين يواصلون الاعتقاد أن كل هذا “سيمر” قد يكتشفون، بعد فوات الأوان، أن التاريخ لا يعود إلى الوراء. إنه يتقدم، ويسحق في طريقه كل من رفض أن يعترفبما يجري أمام عينيه.