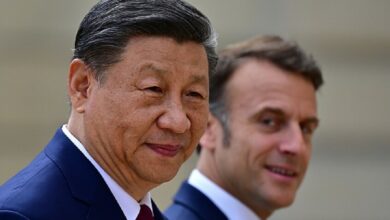الكاتب و المحلل السياسي نزار الجليدي يكتب/ المعارضة التونسية: مستنقع أخلاقيّ وإفلاس سياسي


يتحدّثون عن الديمقراطية، لكنهم لا يتحدّثون يومًا عن الوطن، لأنهم لم يهتمّوا أبدا بالمسألة الوطنية ولا بالتونسيين. يهاجمون الدولة من دون أن يقدّموا أي بديل. بين تحالفات مريبة، وملفات قضائية ثقيلة، ومحسوبية فاضحة، ونتائج انتخابية هزيلة، وجدت”المعارضة” التونسية نفسها في وضعية موت سريري. ومع الخلط بين الإنتقاد والتخريب، لم تعد المعارضة الحالية خيارًا بديلا للمستقبل. تحوّلت إلى عرضٍ من أعراض المشكلة.
لم تعد تونس تعيش اللحظة السياسية نفسها التي عرفتها سنة 2011. لقد عبر البلد عقدًا كاملًا من الأوهام، والتسويات السامّة، والانهيارات التي جرى تبريرها باسم الانتقال الديمقراطي. اليوم، تحاول الدولة أن تنهض من جديد، وأن تستعيد صلاحياتها، وأن تعيد حدًّا أدنى من النظام والأمن. إزاء هذا التوجّه، تتحرّك معارضة صاخبة، تقدّم نفسها بوصفها ضمير البلاد. ولم تكن كذلك يومًا.
ما يلفت الانتباه ليس حدّة النقد — فالنقد مشروع في كل جمهوريات العالم — بل فراغه. لا مشروع اقتصادي قابل للتطبيق. لا رؤية مؤسساتية متماسكة. لا مقترحات اجتماعية مُهيكلة. في المقابل، خطاب إدانة ركيك على المنابر الإعلامية، منفصل عن واقع تونس، وموجّه في الغالب إلى الخارج. معارضة تُكثر الكلام، لكنها لا تشرح أبدًا كيف يمكن تجاوز المشاكل الحقيقية.
الأخطر من ذلك أنّ هذه “المعارضة” بُنيت على تحالفات وخيارات أثقلت كاهل البلاد. بين 2011 و2021، لعبت بعض رموزها دور الغطاء السياسي لقوى ظلامية دمّرت الدولة، وأضعفت المجتمع، وفتحت الباب أمام الفوضى والإرهاب. واليوم، يحاول هؤلاء أنفسهم إعادة تدوير مواقعهم كممثلين للشرعية، وكأنّ التاريخ قد مُسح واختفى.
هذا التشخيص لا يهدف إلى تحريم النقد ولا إلى تحصين السلطة. إنّه يطرح سؤالًا بسيطًا وحاسمًا في آن واحد: من يتحدّث باسم التونسيين، وبأي شرعية؟ لأنّ معارضة بلا شعب، وبلا حصيلة، وبلا انسجام، لا تمثّل بديلًا. إنّها عرقلة. وتونس لا ينقصها المزيد من الأزمات.
معارضة متعالية، غائبة عن واقع تونس
أول صفة جامعة للمعارضة التونسية الحالية هي الانفصال. انفصال انتخابي قبل كل شيء. الأرقام لا ترحم. في كل استحقاق انتخابي منذ عقدين، تحصد هذه الوجوه نتائج هامشية، لا تتجاوز في كثير من الأحيان أجزاء رمزية من الأصوات. “صفر فاصل” تحوّل إلى لقب قاسٍ، لكنه كاشف لسحبٍ صريح للثقة الشعبية.
ثم يأتي الانفصال الاجتماعي. هموم التونسيين الحقيقية — الغلاء، التشغيل، الخدمات العمومية، الأمن — نادرًا ما تُطرح إلا كشعارات عامة. الخطاب يبقى تجريديًا، قانونيًا، وأحيانًا وعظيًا. يتحدّثون عن الإجراءات، فيما تتطلب تونس حلولًا. يتحدّثون عن المبادئ، فيما يطالب المجتمع بالاستقرار.
وأخيرًا، الانفصال السياسي. جزء من هذه المعارضة يبدو أنه تخلّى عن إقناع التونسيين، وفضّل البحث عن اعتراف في الخارج. بيانات بلغات أجنبية، مقالات في منابر دولية، تلميحات إلى ضغوط دبلوماسية: مركز الثقل انتقل. النقاش الوطني استُبدل بعرضٍ مسرحي تُقدَّم فيه تونس كدولة عاجزة.
هذه الوضعية تطرح إشكالًا جوهريًا. انتقاد الدولة حقّ مشروع. الادعاء بالحديث باسمها دون سند شعبي مسألة أخرى تمامًا. المعارضة التونسية تخلط في كثير من الأحيان بين الظهور الإعلامي والشرعية السياسية. والحال أنّ الوزن السياسي، في أي ديمقراطية، لا يُقاس بعدد المقابلات الصحفية، بل بالقدرة على التجميع، والاقتراح، وتحمل المسؤولية.
في هذا الفراغ، ازدهرت معارضة الموقف لا المشروع. تعارض بدافع العادة، بلا ترتيب للأولويات، بلا تمييز، وبلا إحساس بالمسؤولية. لا تواكب، لا تبني، لا تُصلح. تعرقل. ومع الوقت، وبكثرة العرقلة، نزعت عن نفسها أي أهلية سياسية.
حمة الهمّامي: الممثل الرسمي لعدم المسؤولية
السؤال ليس ما إذا كان حمة الهمّامي معارضًا — فهو معارض بطبعه، مغرم بذاته — بل السؤال: يعارض ماذا، وباسم ماذا؟ منذ سنوات، اختزل حضوره السياسي في وضعية واحدة: أن يكون ضدّ. ضدّ الحكومات، ضدّ الأغلبيات، ضدّ أي مسار تغييري. دائمًا ضدّ. لكن نادرًا ما كان مع شيء محدّد، واضح، قابل للتطبيق.
أين هو اليوم، حين تحاول الدولة استعادة توازنها بعد عقد من الانحراف؟ ماذا يقترح، خارج منطق الشجب والتنديد؟ ما تكشفه السنوات الأخيرة هو رجل ينتظر الموجات أكثر مما يصنعها، يركب الغضب الشعبي حين يظهر، لكنه يعجز عن تحويله إلى مشروع سياسي متكامل. هذا الغياب في الرؤية يفسّر، إلى حدّ بعيد، لماذا ظلّ وزنه الانتخابي رمزيًا لا يتجاوز حدود الشعار.
المفارقة تصبح أكثر خطورة عند العودة إلى ماضيه السياسي. يعرّف بنفسه كاشتراكي وديمقراطي. لكن حمة الهمّامي شارك، مع غيره من رموز المعارضة، في تطبيع وجود الإسلاميين في الحكم خلال العشرية السوداء. بموافقته — المباشرة أو غير المباشرة — على إدماج حركة النهضة في اللعبة المؤسساتية، ساهم في تبييض تيار أضرّ بالدولة، وأفقَر البلاد، وشرخ المجتمع. لم يكن ذلك قدرًا محتومًا، بل كان خيارًا سياسيًا محسوبًا.
اليوم، تتكشّف التناقضات. حمة الهمّامي نفسه يعترف بحجم الكارثة التي خلّفها الإسلاميون قبل 2021، ويصفها أحيانًا بوضوح. لكن عندما انطلق مسار سياسي أنهى تلك الهيمنة، اختار الاصطفاف في معارضة جذرية. لا استنادًا إلى اختلاف استراتيجي واضح، بل بدافع العادة. هذا التناقض غذّى صورة انقسام داخلي: وعي بحجم الخراب، مع عجز عن تحمّل تبعات هذا الوعي.
في الخطاب الشعبي، صاغ التونسيون عبارة تختصر هذا الإحساس: “حمة ضدّ”. عبارة غير أنيقة، لكنها معبّرة. أن تكون ضدّ كل شيء ليس خطًا سياسيًا. إنه هروب من المسؤولية. ومع مرور الوقت، وبالإصرار على رفض أي التزام فعلي، حبس حمة الهمّامي نفسه في دور المعارض المهني: يُحترم لخطابه، ولا يُتبع لمشروعه.
الديمقراطية لا تختزل في الاعتراض الدائم. هي أيضًا قدرة على الاقتراح، وعلى الحسم، وعلى تحمّل المسؤولية. في هذا المجال تحديدًا، لم يخطُ حمة الهمّامي الخطوة الحاسمة قط. لم يصبح رجل دولة، رغم تقدّمه في السن. بقي رجل منابر.
محمد عبّو: وين تميلي، وتبعدي مكتوبك توليني
بنى محمد عبّو صورة رجل قانون صارم، مقاتل ضدّ الظلم، ومدافع لا يلين عن الحريات. لكن عند اختبار هذه الصورة بالواقع، تبدأ بالتصدّع. فما يقدّمه كخطّ أخلاقي ثابت يبدو، في كثير من الأحيان، خطابًا متحوّلًا، يُعاد ضبطه حسب الظرف والتحالفات القائمة.
يتحدّث عن الاعتداء على حرية التعبير، في حين أنه حاضر في كل الفضاءات: القنوات التلفزية، الإذاعات، المظاهرات، المقالات والبيانات. ينتقد رئيس الجمهورية بلا أي عائق، وغالبًا بنبرة تتجاوز الخلاف السياسي إلى تعمّد قلة الاحترام. مناداة رئيس الدولة باسمه المجرّد، دون صفة أو تحفظ، ليست شجاعة سياسية. إنها استفزاز محسوب. وحين يصدر هذا السلوك عن وزير سابق، يفرض سؤالًا بسيطًا: هل الهدف الدفاع عن مبدأ، أم تغذية طموحات شخصية؟
هذا الالتباس يتعمّق حين يتحدّث عبّو عن تجربته في الحكم. يقدّمها باعتبارها مرحلة نزاهة وتوازن، متناسيًا السياق السياسي الذي أتاحها. وصوله إلى المسؤولية تمّ عبر تحالفات مع الإسلاميين، وهي تحالفات يهاجمها اليوم بنفس الحدّة التي قبل بها بالأمس. المبدأ، في خطابه، ثابت شكليًا؛ أمّا المعسكر فيتبدّل مرارا وتكرارا.
منذ 2021، تتحوّل هذه الازدواجية إلى عادة. مع سقوط الهيمنة الإسلامية، يعبّر عبّو عن ارتياحه، ويفرح بسقوط النهضة باعتباره نهاية مسار يقول إنه قاومه. بل يذهب أحيانًا إلى نسب الفضل لنفسه. لكن سرعان ما يعيد تموقعه في مواجهة الدولة، دون أن يشرح ما الذي تغيّر جوهريًا في قراءته. النتيجة سلسلة من الانعطافات تترك انطباعًا دائمًا بالانتهازية. ومع كل تغيير في الهدف، يفقد الخطاب جزءًا من مصداقيته.
ثمّة زاوية يتجنّبها محمد عبّو بعناية: مسؤوليته السياسية عن خيارات كانت لها تبعات ثقيلة. العفو التشريعي العام لسنة 2011، الذي دافع عنه إلى جانب رموز أخرى من “المرحلة الانتقالية”، أطلق سراح عناصر ساهمت لاحقًا في تغذية العنف والإرهاب طوال عقد كامل. هذا الرابط لا يُعترف به. يُلتفّ عليه، يُخفّف، ويذوّب في تجريدات قانونية.
المسألة، في النهاية، ليست حقّ محمد عبّو في النقد. فهو يمارس هذا الحق بقدر واسع من التحرّر. المسألة هي رفضه تحمّل مسؤولية ما أيّده، أو شرّعه، أو جعله ممكنًا. الأخلاق في السياسة لا تُنتقى انتقاءً. وإن تحوّلت إلى ذلك، تصبح أداة. ومع الإصرار على استخدامها بهذا الشكل، حوّل محمد عبّو المطلب الأخلاقي من مبدأ جامع إلى “ميحي مع الارياح”.
منصف المرزوقي: معارض اختار الأجانب… ضدّ بلده
في ما يخصّ منصف المرزوقي، قلت الأساس سابقا في منابر أخرى، وبإسهاب. ومنحته وقتًا إضافيًا يكاد يكون إشهارا مجانيا لا يستحقه. يكفي إذًا التذكير بخطوط عريضة لمسار يلخّص، وحده، انزلاق معارضة انفصلت تمامًا عن مفهوم المصلحة الوطنية. بل اتخذت من الإضراربالوطن منهجا وعقيدة.
الرئيس السابق المؤقت للجمهورية لم يتقبّل يومًا خروجه من السلطة. بدل أن يتحمّل مسؤولية الفشل السياسي للتجربة التي جسّدها، اختار الإضرار بتونس إلى أقصى حدّ ممكن. من الخارج، يضاعف مداخلاته ضدّ بلده، عبر منصّات لم تُخفِ يومًا عداءها للدولة التونسية. لم يعد الأمر نقدًا داخليًا. إنه تحويل متعمّد للصراع السياسي إلى الخارج بأيدي أجنبية.
الأحكام القضائية الصادرة في حقّه ليست تفصيلًا ثانويًا. إنها نقطة تحوّل. أن يُدان بأحكام ثقيلة، من بينها قضايا ذات طابع إرهابي، ثم يواصل تقديم نفسه كـ”ضمير أخلاقي” للمعارضة، فهذا هروب إلى الأمام. خطاب الضحيّة لا يمحو خطورة الوقائع التي ثبّتها القضاء التونسي، ولا الرسالة السياسية الكارثية التي يبعثها رئيس دولة سابق مُدان ويواصل نشاطه الإعلامي كأن شيئًا لم يكن.
الأكثر إشكالًا هو طبيعة خطابه. المرزوقي لا يكتفي بانتقاد السلطة القائمة. هو يدعو صراحة إلى ضغوط خارجية، ويطالب بعزل بلده، ويصطفّ مع أجندات إقليمية لا علاقة لها بالأولويات التونسية. هذه معارضة عابرة للحدود، لم يعد هدفها إصلاح الدولة، بل تدميرها.
المفارقة صارخة. بينما تحاول تونس استعادة سيادتها بعد عقد دمّره حكم الإسلاميين، ينشغل رئيسهم (للتذكير فقط) بتقويض شرعية تونس في الخارج. لم يعد يتحدّث باسم تيار سياسي منظّم، ولا باسم قاعدة انتخابية. يتحدّث باسم نفسه، ودائرته الضيّقة، والمنابر التي تفتح له أبوابها.
في هذه المرحلة، لم يعد منصف المرزوقي يمثّل معارضة. هو يمثّل قطيعة. قطيعة مع المسؤولية، مع الذاكرة الجماعية، ومع الفكرة البسيطة التي تقول إن الخلاف السياسي يمكن أن يُدار دون الإضرار بالأوطان. لذلك لم يعد عنصرًا مركزيًا في هذا النقاش. هو أقصى تجلّيات الأزمة، لا البديل.
أحمد نجيب الشابي: سائح سياسي ومحسوبية عائلية
يقدّم أحمد نجيب الشابي نفسه كأحد “الرموز التاريخية” للمعارضة التونسية. الصورة جذّابة. أمّا الواقع فأقلّ بكثير. مساره لا يشبه سيرة سياسية متماسكة بقدر ما يشبه سلسلة محطّات عابرة، بلا ارتكاز حقيقي ولا حصيلة ملموسة. من حقوق الإنسان إلى التحالفات الحزبية، من وعود التجديد إلى إعادة التموضع الظرفي، عبر الشابي العقود من دون أن يبني يومًا ميزان قوى فعلي.
انتخابيًا، الحكم واضح. الأحزاب التي قادها أو مثّلها لم تنجح قطّ في تجاوز دائرتها الضيّقة. الاستحقاقات توالت، والنتائج بقيت هزيلة. هذا الفشل المتكرر لم يؤدّ أبدًا إلى مراجعة ذاتية. ظلّ الشابي حاضرًا في المشهد الإعلامي، كأن طول البقاء يعوّض غياب الشرعية الشعبية.
إلى هذا الفراغ السياسي، يُضاف إشكال أعمق: الخلط بين الصالح العام والتصرّف العائلي. لماذا آلت الأمانة العامة لحزبه إلى شقيقه عصام الشابي؟ وعلى أي أساس، غير القرب العائلي؟ وكيف يمكن تفسير الحضور الإعلامي المكثّف لابنه لؤي الشابي، الذي دُفع إلى المنصّات الرقمية والفضاءات السمعية البصرية من دون تجربة سياسية أو عمل ميداني يُذكر؟ المسألة هنا ليست أخلاقية فقط، بل سياسية بامتياز. في بلد سئم الامتيازات والوراثة، هذا النمط ينسف من الداخل أي خطاب عن الديمقراطية أو التجديد.
هذه الانزلاقة ليست تفصيلاً. إنها تعبّر عن تصور ملكي أرستقراطي للمعارضة السياسية، حيث تتحوّل الأحزاب إلى أدوات توريث، وتغدو الكلمة العامة إرثًا عائليًا. بينما تحتاج تونس إلى أفكار وبرامج ونخب جديدة، تجد نفسها أمام سلالات سياسية بلا قاعدة شعبية.
ثم يأتي العامل القانوني ليزيد الصورة التباسًا. الإدانة في قضية تآمر على أمن الدولة ليست حادثًا عابرًا. إنها معطى سياسي ثقيل يطرح أسئلة حول المسؤولية وحسن التقدير والولاء للوطن. في هذا المستوى، لم تعد وضعية “الضحية” كافية لإخفاء فشل مسار لم ينجح يومًا في تحويل المعارضة إلى بديل.
أحمد نجيب الشابي لم تقصه السلطة بل ما فعلت يداه. و تجاوزه الشعب قبل ذلك بأعوام. وهذا الانفصال لم يعد ظرفيًا. لقد أصبح بنيويًا.
عيّاشي الهمّامي: من الظلّ المؤسّساتي إلى التآمر
عيّاشي الهمّامي ليس شخصية شعبية. وهذه بالذات هي المفارقة التي تجعل تسويقه الدولي مثيرًا للريبة. في الخارج، يُقدَّم كرمز من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان. في الداخل، يكاد يكون مجهولًا لدى الرأي العام التونسي. هذا الانفصال ليس صدفة، بل يعكس نمطًا من المعارضة يخاطب السفارات والمنظمات غير الحكومية أكثر مما يخاطب التونسيين.
مروره بحكومة الفخفاخ سنة 2020 يظلّ معطى سياسيًا مركزيًا. فقد شغل منصب وزير مكلّف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني داخل حكومة كانت مدعومة من الإسلاميين. كان إذن جزءًا من منظومة يدّعي اليوم محاربتها، أو الدفاع عنها، أو الاثنين معًا — لم يعد الأمر واضحًا. لكن لا يمكن لمن ساهم في المشكلة أن يقدّم نفسه لاحقًا كحلّ.
أثقل فصول هذا المسار يبقى ملف المحكمة الدستورية. في لحظة مفصلية، كان تركيزها شرطًا أساسيًا للتوازن المؤسّساتي، تراكمت العراقيل. إجراءات مطوّلة، ذرائع تقنية، تعطيل متواصل. النتيجة معروفة: حتى بعد سنوات، ما زالت الدولة تعاني من تشابكات قانونية ورثتها عن تلك المرحلة. الشبهة هنا ليست مجرّد افتراض. هي شبهة سياسية، تندرج في سياق كانت فيه حركة النهضة المستفيد الأكبر من إبقاء الضبابية المؤسّساتية، وكان عيّاشي الهمّامي أحد من يضبطون الإيقاع.
ما تلا ذلك يؤكّد منطق الاستمرارية. إدانة عيّاشي الهمّامي في قضية تآمر على أمن الدولة لم تأتِ من فراغ. هي حلقة في مسار اتّسم بولاءات مشبوهة، ومسؤوليات جرى الالتفاف عليها، ومحاولات متأخرة لإعادة التموضع. الضجّة الإعلامية الدولية التي رافقت الحكم تقابلها لامبالاة تامّة داخل تونس، وهو ما يعكس فجوة عميقة بين الصورة المصدَّرة والواقع المُدرك.
ما يُقدَّم كمعركة من أجل الحقوق يبدو، في العمق، سياسة كواليس، ودبلوماسية موازية بلا سند وطني. حين انهارت المنظومة التي أتاحت وصوله إلى السلطة، حاول عيّاشي الهمّامي العودة من الباب الأخلاقي لما خسره عند الباب السياسي. الحساب فشل. والحكم، رغم خفّته النسبية، أسدل الستار على مرحلة.
في هذا المسار، لا توجد مفاجآت. توجد استمرارية. استمرارية التزام خدمة مصالح محدّدة، ثم حاول أن يُعاد تدويره تحت مسمّى آخر. الفصل الأخير من مسيرة عيّاشي الهمّامي ليس ظلمًا. إنه منطق الأشياء. إنها كلفة النفاق.
المرآة الدولية الزائفة: حين تعيش المعارضة على صدى الخارج
الركيزة الأخيرة لهذه المعارضة عديمة الشرعية والجدوى ليست شعبية ولا سياسية. إنها إعلامية. بعد أن فقدت أي امتداد وطني، لجأت هذه الوجوه إلى فضاء موازٍ: الصحافة الأجنبية والقنوات العابرة للحدود. هناك، حيث لم تعد تمثّل شيئًا في تونس، تتحوّل، بمجرد لعبة استضافات، إلى “معارضين كبار”، و”أصوات لا غنى عنها”، و”رموز مقاومة”. إنها حكاية إعلامية، تُكرَّر حتى الابتذال.
هذا الانفصام ليس تفصيلاً عابرًا. إنه يقوم على منطق مُحكم: تضخيم أشخاص مهمَّشين داخل تونس لتحويلهم إلى مراجع في الخارج. لا وزنهم الحقيقي يهم، ولا نتائجهم الانتخابية، ولا مصداقيتهم الاجتماعية. ما يهم هو قابليتهم للاستخدام السردي. إنهم يخدمون رواية، لا وطنًا. تلعب قنوات مثل الجزيرة، وفرانس 24، وغيرها دورغرفة الصدى، فتمنح وهمَ معارضةٍ منظَّمة حيث لا يوجد سوى تكتّل من الضغائن.
أما التونسيون، فقد حسموا أمرهم. لا قيمة سياسية لديهم لعدد الدعوات على الشاشات الأجنبية. الشرعية لا تُقاس بالتصفيق الدولي، بل بالقبول الوطني. ما يقوله القطريون أو المغاربة أو الأتراك أو الفرنسيون لا أثر له على الواقع التونسي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول التي تموّل أو تُلهم هذه الخطوط التحريرية. السيادة لا تُفاوض على منصّة تلفزيونية.
الأخطر من ذلك أن هذا الترويج الخارجي استُخدم مرارًا لمهاجمة الدولة التونسية ككل، لا مجرد سلطة أو سياسة بعينها. الخطاب في الخارج يعيد إنتاج العناصر نفسها: نزع الشرعية عن المؤسسات، الدعوة إلى الضغوط، وبثّ الشكّ العام. هذا لم يعد معارضة. إنه خيانة منهجية، معلنة، وأحيانًا مُتفاخَر بها. هنا تُتجاوز الحدود بين النقد السياسي والعداء لتونس.
لذلك، لا بدّ من إعادة الأمور إلى نصابها. تونس ليست موضوع نقاش على شاشات أجنبية. تُدار على أرضها، بمواطنيها، وبقيودها وخياراتها. المعارضة التي لا تعيش إلا عبر الخارج توقّفت عن كونها قوة سياسية. لقد تحوّلت إلى منتج إعلامي، يُستهلك في أماكن أخرى، ويرفضه الشعب التونسي.
الانقسام الحقيقي لم يعد بين سلطة ومعارضة. بل بين دولة تحاول أن تُعيد بناء نفسها، وطبقة لم تعد موجودة إلا بالضجيج الذي تُحدثه خارج حدود الوطن. وعلى هذا الأساس، اختار التونسيون الالتفاف حول دولتهم ووطنهم منذ زمن طويل.