إدوارد سعيد الراوي الذي ورث “أرض الحكاية”
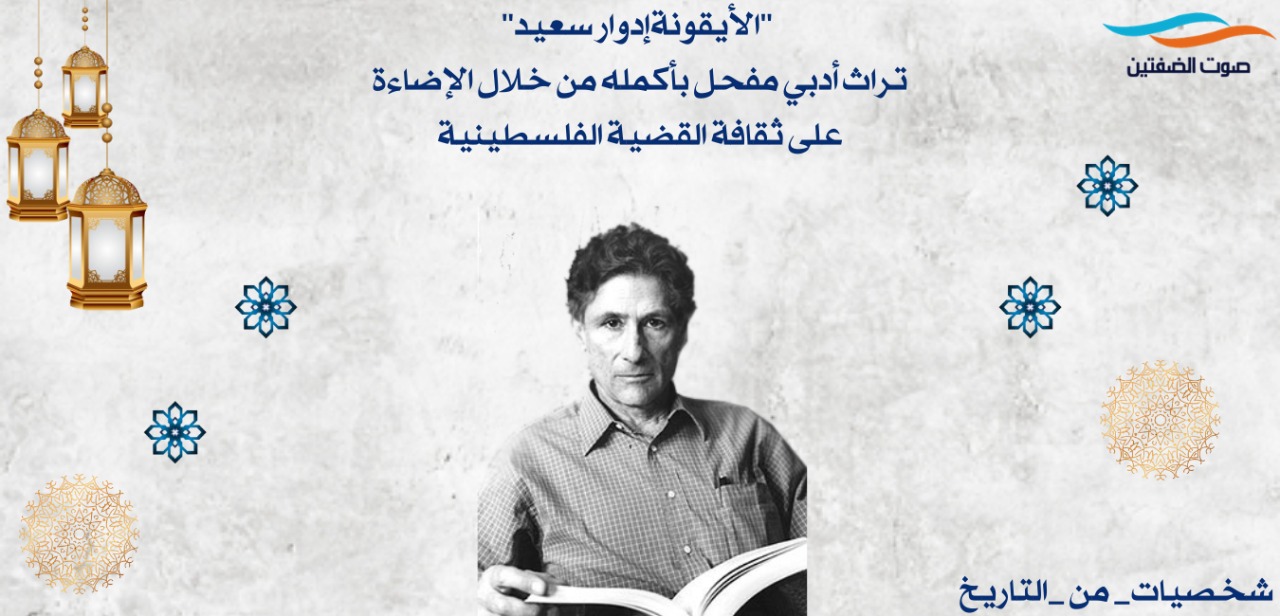
ما إنْ يستهويك البحث عن الكاتب الفلسطيني والأكاديمي الأميركي إدوارد سعيد إلا وتجد نفسك تقف أمام سيرة مثيرة للفضول، امتدت لعقود من الزمان، وتجاوزت القارات والثقافات واللغات، إذ ترجمت مؤلفاته من الإنجليزية، التي كتب بها، إلى العربية واليابانية والتركية والصربية والماليزية بجهد علمي فريد، لكن اللافت حقاً أنه ورغم هذا الحضور الأكاديمي المهيب، تظل سيرة الغياب مهيمنة على الوجه الإنساني الثري في حياة إدوارد سعيد إلا من شذرات مبعثرة هنا وهناك، قليلاً ما ترصد العلاقة الكاملة بين الكاتب وعالمه، كأن قدره أن يكون منفياً “خارج المكان”، وفقاً لسيرته الذاتية التي تحمل العنوان ذاته.
ولعل من المفارقات أن مولده في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1935، جاء على يد قابلة يهودية بالقدس، كانت حريصة على زيارة أسرته المرة تلو المرة، لتطمئن على نموه، وتعانقه عناق الأحبة، وفقما سجل في مذكراته. لم تكن “السيدة باير”، ذات الأصول الألمانية، تدرك بالطبع ما تخبئه الأقدار لهذا الوليد، الذي ستضعه إحدى المنظمات اليهودية المتطرفة في الولايات المتحدة على قائمة الاغتيالات وهو في الثلاثين من عمره، بعدما أدى دور راوي الملحمة الفلسطينية وصحح مسار الأساطير التي سعت إسرائيل إلى ترسيخها في أذهان العالم عن الأرض والشعب؛ “كانت فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض، أما الشعب فلم يكن هناك من فلسطينيين!”.
محاولة ترسيخ هذه المروية الإسرائيلية ونظائرها في أذهان العالم، جعلت إدوارد يسطر رواية شعبه التاريخية، ليمسي صوتاً رصيناً لفلسطين، يتدفق بعقلانية في الإذاعات العالمية، ويثير جدلاً متواصلاً على صفحات الصحافة الغربية، بلغة هي لغتهم، ومنهج يستند إلى المنطق الذي يدركه عقلاؤهم؛ ليدحض أكاذيب المرويات الإسرائيلية بإسقاط القناع عن وجه خرافتها بما جرت به وقائع الأيام. وبصرف النظر عما آل إليه الأمر الواقع لأرض وخريطة فلسطين، لكن تاريخ الرجل يروي كيف أرقت كتاباته في ستينيات القرن العشرين المروية الإسرائيلية عن “أرض الميعاد”، وفق الأدبيات العبرية. لعلنا نستطيع هنا أن نلملم شتات الأبعاد الدرامية في الصورة الإنسانية التي تخفت وراء سيرته العلمية، ونعيد رصد التفاصيل التي غابت عن حياته الثرية، فماذا تروي السيرة يا تُرى؟
البداية من “خارج المكان”
قدّم إدوارد سعيد مذكراته في طبعتها العربية بقوله، “بعد سنوات من حياتي خارج العالم العربي؛ هي سنوات دراسة وتعليم وعيش وكتابة كلها باللغة الإنجليزية، اتخذت قراري بُعيد حرب 1967، بأن أعود سياسياً إلى العالم العربي، الذي كنت قد أغفلته خلال سنوات التعليم والنضج الطويلة تلك. ولكن ما عدتُ إليه، لم يكن له أن يكون عالم طفولتي؛ تلك الطفولة التي دمرتها أحداث عام 1948، والثورة المصرية، والاضطرابات الأهلية اللبنانية التي بدأت عام 1958”.
يتابع، “كان العالم العربي الجديد عالماً سياسياً وثقافياً، على الصعيدين الشخصي والعام، يتكوّن من عناصر عديدة، لكن علاماته الفارقة عندي كانت الهزيمة العربية، وانبثاق الحركة الفلسطينية والدروس الخصوصية في اللغة والأدب العربيين التي كنت أتلقاها يومياً، خلال عام بأكمله على يد الأستاذ أنيس فريحة، المَعين الذي لا ينضب من اللغات السامية كلها. إلى ذلك نما لديَّ شعور متزايد بأنه إذا كنت أشعر بوجود هوة من سوء التفاهم تفصل بين عالمَيَّ الاثنين؛ عالم بيئتي الأصلية وعالم تربيتي، فإن مهمة تجسير تلك الهوة إنما تقع عليَّ وحدي دون سواي. كان عليَّ أن أعيد توجيه حياتي لتسلك حركة دائرية تعيدني إلى نقطة البداية، مع أني كنت قد بلغت نهاية الثلاثين من عمري، اخترت أن أستعيد هويتي العربية”.
يستطرد قليلاً ويسجل، “إنها صورة شخصية غير تقليدية لتلك العلاقة التي تنطوي على قدر من التوتر والتركيب، الذي يُظهر سيرة عربي أدت ثقافته الغربية، ويا لسخرية الأمر، إلى تأكيد أصوله العربية، تلك الثقافة التي تلقي ظلال الشك على الفكرة القائلة بالهوية الأحادية، وتفتح الآفاق الرحبة أمام الحوار بين الثقافات”. هنا يظهر الانتماء الإنساني لإدوارد سعيد؛ “فيؤيد هجنة الهويات، ويدين صراع البشر القائم على الأصول والأعراق وحدود الجغرافيا”، بحسب توصيف فخري صالح في كتابه “إدوارد سعيد دراسات وترجمات” (2009). ربما كان هذا هو المفتاح الرئيس في حياة إدوارد الذي جعل منه إنساناً استثنائياً مسافراً بين الثقافات؛ لا حاجة له إلى جواز سفر ولا ختم عبور بين الحدود والألسن التي ترجم إليها.
فضول الروائي
في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1991، كشف إدوارد سعيد، في أحد حواراته الإذاعية المتعددة مع ديفيد بارساميان لراديو “البديل” الأميركي، عن سيرة الوجع في نكبة فلسطين بقوله، “ما قَتلنا طوال السنوات الأربعين الماضية هو الإنكار، وحقيقة أنهم غير مسؤولين؛ لذلك نبدو وكأننا أيتام؛ كأنه ليس لدينا أصول، ولا حكاية، ولا سلالة كشعب، إن ما نتحدث عنه هو الاعتراف بالتاريخ، هذه هي المسألة الأولى. أما الثانية فإنها تضعنا على الأقل على قدم المساواة مع الإسرائيليين”.
عناية إدوارد بمدونة التاريخ وغياب الوثائق الثقافية، بما فيها الأدب، كان لها دور أعمق في كتابيه العمدة، “الاستشراق” و”الثقافة والإمبريالية”، إذ يقول، إن “الرواية تلعب دوراً مهماً على نحو استثنائي في المساعدة على خلق مواقف إمبراطورية نحو بقية العالم”. فماذا عن المؤثرات الفكرية التي أوحت إليه بهذا الاستنتاج، لدرجة أن كَثُر استشهاده ببعض الأشعار والمقاطع الروائية إلى جوار المنطق والمنهج العلمي بالطبع داخل أطروحاته؟
بالعودة إلى المؤثرات الفكرية في نشأته، يشير إدوارد إلى هناك؛ حيث الطفولة وبداية السيرة، ويكشف في حوار له، أن الرواية كانت الأكثر تأثيراً في طفولته المبكرة، إلى جوار الموسيقى. يقول، “قرأت تشارلز ديكنز ووالتر سكوت، وروائيي القرن التاسع عشر من أمثال كونان دويل وجون باكان وإدغار رايس بوروز مؤلف طرزان، وألكسندر دوما، والروايات المسلسلة”، ولم يفته بالطبع أعمال شكسبير. لكن من بين كل الروايات التي أثرت فيه كان أهمها رواية (إيفانهو) لـ”والتر سكوت”، التي قرأها في الثانية عشرة من عمره، بعدها جاءت رواية “روبنسون كروز”، سالفة الذكر، إضافة إلى تأثره في ما بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من عمره بفلوبير ومارسيل بروست، وكُتب الفلسفة التي تعرّف إليها ما بين عاميه الواحد والعشرين والثاني والعشرين من عمره، ولكنه يعود فيجزم، “يبقى التأثير الأطول في حياتي بأسرها من اليفاعة وحتى الآن للروائي جوزيف كونراد”، مشروع أطروحته للدكتوراه وأول كتبه.
في سن مبكرة، يحددها ما بين الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره، (كان هذا بين عامي 1947 و1948)، فكّر إدوارد أن يكتب القصة أو الرواية، عقب تأثره برواية الكاتب البريطاني دانييل ديفو الشهيرة “روبنسون كروزو”؛ وهي سيرة ذاتية تخييلية، يقول عنها، “كنت مسحوراً بفكرة روبنسون كروزو بأسرها؛ ثيابه، والببغاء، وشخصية (جمعة). تلك التي كانت لغزاً تاماً بالنسبة لي، ولم أتمكن من التماهي معه، أو فهم الكائن الذي عليه؛ لأنه ببساطة صامت في الرواية”.
يضيف، “الحكاية جذبت انتباهي، وأذكر أنني حاولت تقليدها وكتابة قصص شبيهة. وذات مرة فكرت في كتابة قصة عن كتاب؛ مغامرات كتاب يُقرأ، ويتنقل من شخص إلى آخر، ثم يُنسى في قطار. وأعتقد الأمر كان فانتازياً حول نفسي، وأنني قد أكون في يوم ما قادراً على التحول إلى كاتب”. ولكن هل حقاً حال القدر بين إدوارد سعيد وسرد الحكاية، أم قُــدِّر له أن يروي سيرة المنفى والشتات الفلسطيني في مدونة السرد التاريخي على نحو مغاير، ويفسح المجال في مروياتها لصوت “الضحية” ليكون صوتاً موازياً يكشف التدليس في الرواية الإسرائيلية لما اقترفته إسرائيل بحق فلسطين، الأرض والشعب.
إدوارد سعيد وعالمه
طفولة إدوار كانت أرستقراطية إلى أبعد حد؛ طفلٌ وُلد في القدس عام 1935 وغادرها في الثانية عشرة من عمره إلى القاهرة عام 1947، مع أسرة ميسورة الحال ترعاه على أكمل وجه، نشأ بين أحضان الروايات والمسرحيات العالمية، يعزف على البيانو من وقت إلى آخر، ويشاهد المسرح والأوبرا بالقاهرة. وحين وصل إلى الثانية والعشرين من عمره درس بالولايات المتحدة الأميركية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1962 عن الروائي البولوني جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية، فهل ثمة علاقة بين إدوارد وعالمه؟
أول خيوط عوالمه نتلمسها هنا في العلاقة بينه وبين كونراد صاحب رواية “قلب الظلام”، وكتابه الأول الصادر عام (1966)، إذ تتمثل في الإشارات الكثيرة إليه في منجزه، بل واعترافه المباشر بالدَّين له، بل لعل استهلالَ إدوارد سيرته الذاتية “خارج المكان” به في مقدمة الطبعة العربية الصادرة عام 2000 دلالةٌ ذات مغزى.
يقول إدوارد، “غادر كونراد وطنه عام 1874 وهو في السابعة عشرة من العمر. عاش في فرنسا وعمل قرابة أربع سنوات في البحرية التجارية الفرنسية، وفي عام 1878 جدّد حياته فجأة؛ فعمل بحاراً في البحرية البريطانية إلى عام 1895 عندما نشر روايته الأولى (جنون ألماير)”.
يعقب إدوارد على هذه المسيرة بقوله، “سحرني في الرجل أنه كتب باللغة الإنجليزية أعماله العديدة من روايات وقصص ومذكرات، وكلها يغرف من حياته الغنية على نحو مستبعد التصديق بوصفه بحاراً ومكتشفاً ومغامراً. ومع ذلك كانت الإنجليزية لغته الثالثة بعد البولونية والفرنسية”.
يذكر، “في كتابي عنه ظل يثيرني، بل إني مهووس به من نواحٍ عديدة. وأحاجج أنه عاش تجاربه في اللغة البولونية لكنه وجد نفسه مَسوقاً إلى الكتابة عن تلك التجارب في لغة ليست لغته، فإذا النتيجة كاتب متفرد في الأدب العالمي من حيث الأسلوب والمحتوى معاً، فما من أحد له نبرة كونراد، وما من أحد حقق تلك الآثار الكابوسية والمقلقة كالتي حققتها كتبه. وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى شعور كونراد بوجود تفارق دائم بين تجاربه وبين اللغة التي استخدمها لوصف هذه التجارب، فكأنه عاش في لغة، وكتب في أخرى. وإذا إدراكه لذلك الاختلال المربك هو في الصميم من كل أعماله”، ولعل في هذه التفاصيل ما يصنع تماساً واضحاً بينهما، خصوصاً أنه عقد بشخصه مقارنة بينهما بشأن عامل اللغة هذا، بل ربما يكون هذا وجهاً من وجوه اختياره لكونراد موضوعاً لأطروحة الدكتوراه.
تأثر إدوارد بكونراد والإشارة إليه على هذا النحو، دفع أكثر من باحث ومؤرخ للتعمق في صلة المقارنة هذه؛ فعَقد أستاذ الأدب الإنجليزي محمد شاهين، شبهاً بين تجربة إدوارد سعيد بالقضية الفلسطينية بنظيرتها لدى “مارلو”، بطل رواية كونراد “قلب الظلام”، عن مغامرته في الكونغو، إذ يروي الأخير قصة الاستعمار على مسمع أربعة من رفاقه بظهر السفينة “نيللي”، التي كانت راسية في مياه نهر التيميز تنتظر هبوب الرياح المواتية لتقلع، وجاهد مارلو لنقلها في شكلٍ روائي؛ لكي يفهمها ويجعلها مفهومة للآخر، فوجد نفسه يروي قصة رحلته إلى الكونغو لإحضار كورتز؛ موظف الشركة السابق، الذي أصبح إلهاً عند الأفارقة وطريداً عند الشركة؛ قصة معقدة ومأساوية وجدت تعبيراً لها في تلك الصيحة الشهيرة التي أطلقها كورتز عندما تراءت له ممارسات الاستعمار البشعة، فلم يجد غير كلمتين. اعتبرهما مارلو التعبير الأدق عما جهد إليه دون طائل في محاولة التعبير عنه؛ “الرعب، الرعب”، وفق ما سجل في مقدمة كتاب “إدوارد سعيد: الثقافة والمقاومة” (2007).
يتابع، “إدوارد هنا مثل مارلو؛ يجهد في تطويع اللغة من أجل الوصول إلى أدق تعبير يصف به القصة المعقدة. وهو مثل مارلو أيضاً يتوجه إلى مستمعيه بين الفينة والأخرى مستفسراً عن قدرته اللغوية في توصيل خبايا الرواية وأجندتها المعقدة إليهم من خلال أقصى درجات التعبير، التي تتسنى للراوي أثناء العملية الروائية. إن الرواية عند إدوارد سعيد هي الثقافة التي تحصّن أصحابها وتحميهم من الذوبان في منظومة الهيمنة التي تُملى عليهم من الخارج”.
ثمة من يفتح أمامنا أوراقاً أخرى من سيرة إدوارد سعيد، المفكر الذي قيـّــد سرد الروائي، إذ يخبرنا بروفيسور العلوم السياسية في كلية هامبشير الأميركية إقبال أحمد، عن سطوة الروائي الأوكراني ذي الأصول البولندية جوزيف كونراد في حياة صاحبنا: “كان كونراد منفياً شأن سعيد. هو لا يقول ذلك، ولكنه يتحدث عن دَين فكري لكونراد، ويصفه بأنه واحد من أهم الشهود الاستثنائيين على دور الثقافة في الإمبراطورية، وعلى مركزية الأفكار في صنعها والحفاظ عليها. لقد فهم كونراد أكثر مما فهم أي روائي آخر كيف أن الإمبراطورية لم تصب بالعدوى أولئك الناس الذين خضعوا لها فحسب، ولكن الذين خدموها أيضاً. لقد فهم الإمبريالية وقوتها الداخلية وجانبها المظلم، كان يتمتع بحس الدخيل؛ لأن أوروبا كانت ذاتاً محتومة بمعنى من المعاني بأن تكرر هذه الدورة من المغامرة الأجنبية والفساد والانحدار، ولكنه رأى ذلك على أنه أمرٌ لا مفر منه. لقد ترك إدوارد الأمر إلى الكاتب الأفريقي والكاريبي والآسيوي ليتخيل البديل ويبدأ بكتابة الماضي. فإدوارد بين الأوائل الذين دفعوا بهذا البحث إلى ما وراء القومية والدولة إلى ما بعد الاستعمار، عابراً الحدود ليفسر العالم والنص بناء على المعادل. كما قد يقول (كثير من الأصوات تنتج تاريخاً)”. “إدوارد سعيد: القلم والسيف” (1998).
القضية الفلسطينية وميراث الخسارة
الخامس من يونيو (حزيران) 1967 في حياة إدوارد سعيد، ابن الاثنين والثلاثين عاماً آنذاك، جعل منه إنساناً غير الذي كانه، فحتى هذه السن انكب على البحث والدراسة، إلى أن شاهد آثار الهزيمة العربية أمام إسرائيل على التلفاز، وهو في مقر إقامته بالولايات المتحدة، ولمس بمعايشته الفرحةَ الغامرة التي اجتاحت الولايات المتحدة إثر النصر الإسرائيلي، لتتصارع بداخله ذكريات مركّبة تضعه على خط المواجهة ليغير المسير والمصير، ويدخل المعترك السياسي بمقالته الأولى “صورة العرب” عام 1968.
في عام 1969 أطلقت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير تصريحاً، جاء فيه، “لم يكن الأمر وكأن هناك شعباً فلسطينياً. إنهم لم يوجدوا”، أصاب سهم مائير سيرة الوجع بداخل إدوارد، فقرر “دحض ما ذهبت إليه، الذي يمازجه شيء من مُنافاة العقل، والشروع بإنطاق تاريخ الخسارة والفقدان الذي ينبغي أن نبوح به، ونحرره دقيقة بدقيقة، وكلمة بكلمة، وإنشاً بإنش”، وفقاً لإدوارد.
يتلمس طرف الخيط ليعيد بناء المرويات التاريخية التي استفزه تلاعب إسرائيل بها حد التزييف عبر تصريحات قادتها، تسبقها بالطبع كتابات وتحليلات كتــّـاب ومتخصصين في الصحف ووسائل الإعلام العالمية، تمهيداً لفرض سيرة تاريخية مزيفة وموازية تخدم أهدف إسرائيل الاستراتيجية لتضرب عقول وأذهان العالم في مقتل.
انتبه إدوارد لـ”خطورة الحَكي”، والأهداف البعيدة المدى لهذا النوع من المرويات، ووقف ليروي للعالم كيف بدأت الحكاية ويدحض أباطيل وأسمار المروية الإسرائيلية بتاريخ البلاد وجغرافيا المكان وطبيعة سكانه، وما الذي كان وأصبحت عليه الأمور.
تزييف المروية التاريخية هذه، كان وراء كتابه “المسألة الفلسطينية” (1979)، الذي سجل فيه، “عقب انتهاء الحرب الأولى التي دارت بين العرب والإسرائيليين، توسعت الأراضي التي كانت إسرائيل تحتلها، حيث زادت عما كانت نسبته 56 في المئة من أرض فلسطين الانتدابية، التي مُنحت لإسرائيل بناء على توصية الأمم المتحدة، إلى 78 في المئة من الأراضي الفلسطينية”، اشتملت على كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ولعل منطق سردية الخسارة هذه، يفرض التنويه إلى أنه في الوقت الراهن تقلصت أراضي خريطة فلسطين إلى 4 آلاف كيلو متر مربع من إجمالي 27 ألف كيلو متر مربع قبل قيام دولة إسرائيل، بما نسبته 15 في المئة من إجمالي مساحة فلسطين، وفقاً لخطة السلام الأميركية الأخيرة التي هندسها غاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره، وأقرها الأخير استناداً لسياسة الأمر الواقع.
من المفارقات هنا أن الرقم “67” سيجسد في حياة إدوارد سعيد علامة فارقة لتاريخ الخسارة فيما هو عام وشخصي، فهو التاريخ المجسد للهزيمة العربية أمام إسرائيل الذي استنهض منه الكاتب السياسي، وهو في الآن ذاته العمر الذي تُوفي فيه، لينتهي به المآل من حيث بدأ. ومع هذا لم يدخر جهداً في أن يقولها ويمضي. فهل كان إدوارد يروي حقاً تاريخ الخسارة التي كان يخشى مواجهتها دائماً، ليكون راوي الملحمة ويصرخ بصوت المهمشين والمنفيين البائسين في الرواية؟ لعل سؤالاً كهذا يكون جوهرياً، خصوصاً إذا نظرنا لما جناه من مسيرته هذه.








